النقد النسوي للأفلام: من محاولات لفك الشفرة الأيديولوجية للفيلم الهوليودي إلى نظرية مؤثرة في الدراسات السينمائية
في آخر أيام العام 1895، داخل قبو بمقهى لو جراند كافيه (Le Grand Café) في مدينة باريس، أقيم أول عرض سينمائي تجاري على الإطلاق، وقد ضم عشرة أفلام قصيرة جدًا صورها الأخوان لوميير لتوثيق الحياة اليومية في فرنسا، ثم تتابعت بعده عروض الأخوين في المكان ذاته.
في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، توالت عروض الأفلام القصيرة جدًا التي لا تتجاوز الدقيقة في مدن عديدة في أوروبا والولايات المتحدة، وأخذت شعبية هذا الفن الجديد في التصاعد مع تطوره السريع الذي أدى إلى تحول التقنية الحديثة من تسلسل للصور المتحركة، إلى منتجات درامية تمزج الصورة بالصوت، وتدهش مشاهداتها ومشاهديها، وتثير مشاعرهم، وتستثير أذهانهم.
على غرار الفنون السابقة على السينما، صارت صناعة الأفلام موضع بحث ودراسة، وبدأ المتمرسون في هذا المجال، من الرجال على وجه التحديد، ينقلون خبراتهم إلى محبات ومحبي السينما ويعرّفونهم إلى الأدوات التي يعتمدون عليها لسرد قصصهم من خلال المنتج السينمائي، وسرعان ما أسس هذا لما عُرّف بالدراسات السينمائية أو دراسات صناعة الأفلام (Film Studies, Cinematic Studies)، إذ تأسست في روسيا البلشفية أول مدرسة متخصصة في تعليم أسس صناعة الأفلام، وهي مدرسة موسكو للسينما التي بدأت نشاطها في العام 1919، ثم لحقت بها بعد عشر سنوات مدرسة فنون السينما التي أنشأتها جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالتعاون مع واحدةً من أهم المؤسسات السينمائية في العالم، وهي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي أنشِئَت في العام ١٩٢٧ بهدف تعزيز صناعة الأفلام الأمريكية ودعم القائمات والقائمين عليها، إلا أن الجانب الأكبر من أهمية وشهرة الأكاديمية تكتسبه من مسؤوليتها عن منح جوائز الأوسكار السنوية واختيار الفائزات والفائزين بها من العاملات والعاملين بصناعة الأفلام، لا سيما تلك التي تنتجها هوليوود.
اجترحت المؤسستان التعليميتان، مدرسة السينما في روسيا ومدرسة فنون السينما في الولايات المتحدة، مناهج دراسية غرضها هو التدريب على صناعة الأفلام حتى تتضاعف أعداد المنخرطين والمنخرطات في هذا المجال فيزداد الإنتاج السينمائي، بيد أن المحتوى التعليمي اتسم في تلك المرحلة المبكرة بالعمومية، فكان لا يفصل بين النظرية المجردة والممارسة العملية، ولكن تغير ذلك مع تطور نظريات صناعة الأفلام وتعددها في خلال العقود اللاحقة تأثرًا بالتيارات السينمائية التي تشكلت في القرن العشرين، وأبرزها: الواقعية الجديدة الإيطالية، والسينما الفرنسية الجديدة، وسينما الواقع، والسينما التجريبية، وهوليوود الجديدة، بالإضافة إلى السينما السريالية.
في خمسينيات القرن العشرين، لم تعد الدراسات السينمائية تقتصر على المؤسسات المختصة بهذا الفرع الأكاديمي حصرًا، فقد انتقلت إلى الجامعات والكليات العامة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وصارت تخصصًا أكاديميًا مستقلًا بذاته داخل كليات الفنون الحرة، والفنون الإبداعية، والإعلام، ثم انبثقت عنه تخصصات أخرى كفلسفة الفيلم، والنقد السينمائي، إلى جانب نظريات تحليل الأفلام التي تشعبت وتماست مع العديد من التخصصات الأكاديمية الأخرى، كعلم النفس، واللسانيات، والأدب، والسيميولوجيا (السيمائيات)، إلا أن الجدل لازم نظريات التحليل السينمائي التي تقوم على أيديولوجيات سياسية واجتماعية أكثر من غيرها، وبالأخص نظرية التحليل الماركسي، ونظرية التحليل النسوي التي تعتبر واحدةً من أكثر النظريات السينمائية حيوية وتجددًا في ظل فحصها المستمر وتوسيع إطارها بشكل متواصل من جانب الأكاديميات وصانعات الأفلام اللاتي بتبنين أجندة نسوية واضحة في إنتاجهن النظري وممارستهن العملية.
يأتي التحليل النسوي للأفلام ضمن ثمار الحراك النسوي في الولايات المتحدة، لا سيما في فترة الستينيات حينما تصاعدت وتيرة الاحتجاج على الأسلوب الذي تتجسد به النساء في المحتوى البصري عمومًا، وقد شق طريقه نحو الساحة الأكاديمية بعد أن نجحت الضغوط التي مارستها العديد من الجماعات الراديكالية الأمريكية والبريطانية من أجل زيادة أعداد الفتيات في الجامعات، وإدخال مناهج تعليمية تعني بتاريخ المرأة ونشأة وأهداف الحركة النسوية، والتي تطورت تباعًا لتصبح تخصصًا أكاديميًا يسمّى بالدراسات النسوية، أو دراسات المرأة والنوع الاجتماعي، أو دراسات النوع والجنسانية.
كلير جونستون: النساء على الشاشة لسن الموجودات في الواقع
بفضل المساعي الأولى لخلق إطار نظري للتحليل والنقد السينمائيين من منظور نسوي، تدافعت موجات تأمل وقراءة للأفلام الكلاسيكية (فترة الإنتاج بين العامين 1913 و1969) من زاوية ظلت مستبعدة في النقد السينمائي منذ نشأته، وقد انجلى على إثرها أن النهج السائد وقتئذٍ، خاصةً في هوليوود، هو بناء الشخصيات النسائية وفقًا للتصورات القارة في المخيال الذكوري عن المرأة، مثلما هو الحال في أفلام المخرج ألفريد هتشكوك، التي انحسرت فيها الشخصيات النسائية في أنماط محددة، بعضها كان نماذج تخفي مكرًا وخبثًا خلف ملامح بريئة وأجسام مثيرة (وفقًا لمعايير الثقافة الاستعمارية البيضاء)، وبعضها الآخر نماذج تتسم بالسذاجة وتتمركز حيواتها حول الذكر حبيبًا كان أو زوجًا أو أبًا.
هذا ما رصدته ووثقته بعض الكتابات التحليلية المؤسسة لنظرية الفيلم النسوي وفي مقدمتها مقالة «المتعة البصرية والسينما الروائية -Visual Pleasure and Narrative Cinema» للورا مالفي أستاذة الدراسات السينمائية والإعلامية البريطانية، وقد جرت الإشارة إلى أفلام هتشكوك بوصفها قرينة تاريخية للنسق السينمائي المتبع في السرد الكلاسيكي الهوليودي، الذي يتخذ زاوية النظر الذكورية ويتوجه إلى الذات الذكورية أمام الشاشة التي تتماهى في شخصية البطل الفاعل والمهيمن.
انغرست البذور الأولى لدراسات الفيلم النسوي في السبعينيات، بأيدي أكاديميات إنجليزيات وأمريكيات تباينت تخصصاتهن بين السينما والدراسات الثقافية، بينما جمعتهن خاصية الاندماج نشاطيًا وعقائديًا مع الحركة النسوية في تلك المرحلة الزمنية، حيث تقاطعت توجهاتهن الفكرية مع معرفتهن الأكاديمية لتنتج منهجًا جديدًا في قراءة وتحليل الأفلام على مستوى الصورة والمضمون؛ منهج يتعامل مع النص السينمائي كونه أداةً أيديولوجية وليس مجرد منتج بسيط للإمتاع والترفيه، ويضع إطارًا لاستكشاف العلاقة بين وجهة النظر التي يتبناها الفيلم وعملية التلقي المتوقعة أو المتخيلة.
يعتبر المجتمع الأكاديمي السينمائي على عمومه أن البريطانيتين كلير جونستون ولورا مالفي هما من مهد الأرضية التأسيسية لنظرية الفيلم النسوي (Feminist Film Study)، بعد أن انبريتا لتحليل مجموعة من الأفلام الكلاسيكية الأمريكية ذات الصيت في مقالتين طليعيتين نشرتهما المجلة الأكاديمية «شاشة -Screen»، التي كانت تصدر عن دار نشر جامعة أوكسفورد، وتكاد لا تخلو مناهج الدراسات السينمائية الأكاديمية من الإشارة إلى كلتيهما باعتبارهما حجر الزاوية في نظرية الفيلم النسوي.
المقالة الأولى كتبتها الباحثة الأكاديمية البريطانية كلير جونستون في العام 1972، وصدرت بعنوان «سينما النساء كسينما مضادة Women’s Cinema as Counter-Cinema»، ولم تتناول فيها السينما الإنجليزية أو الأوروبية بالدراسة والتحليل، بل صبت تركيزها على هوليوود التي اعتبرتها النموذج الأكثر جدوى لدراسة وضع المرأة على الشاشة الفضية، أخذًا بأن أفلامها هي الأكثر انتشارًا، ومنها تخرج أنواعًا جديدة من الأفلام، على حد قولها.
قبل أن تصدر هذه المقالة كانت قد بدأت تظهر بعض المقالات النقدية للأفلام الأوروبية والأمريكية التي تتخذ زاوية نسوية، أغلبها كانت تنشره مجلة «النساء والسينما – Women and Cinema» الأمريكية التي استمر صدورها حتى العام 1975 بعد سبعة أعداد فقط. لكن هذه المقالات لم تكن تستند إلى معايير واضحة أو طريقة محددة في عملية تحليل الفيلم ونقده بناءً على الأيديولوجية النسوية، وهذا ما جعل كلير جونستون تشدد على الحاجة الماسة لاستحداث منهجية علمية للنقد السينمائي النسوي.
استعملت كلير في دراستها العديد من مدارس التحليل السينمائي كمدخل لبناء منهجيتها للتحليل النسوي، وهو ما أضحى محل نقد في داخل دوائر الدراسات السينمائية النسوية في مرحلة لاحقة، نظرًا لغياب الانسجام بين هذه المدارس وصعوبة الجمع بينها للخروج بنتائج واقعية.
تشير كلير إلى التحليل الاجتماعي الذي تعتبره مفتاحًا لفهم السينما الهوليودية المؤدلجة، التي يهمين عليها الرجال وتنتج أفلامًا متحيزة إليهم، وتجادل بأن الاعتماد عليه يكشف أن المرأة على الشاشة ليست المرأة في الواقع وإنما هي تمثيل لما تعنيه المرأة بالنسبة للرجل، ولهذا تقول إن «النساء غائبات في هذه الأفلام، رغم التركيز الكبير عليهن كعنصر رئيس في الصورة الفيلمية»، مؤكدةً أن الشخصيات النسائية ليست سوى امتداد لنظرة الرجل لها ومجرد تابع غير فعال وسلبي له.
تطرقت كذلك كلير إلى التحليل السيميائي الذي يعمد إلى استقراء وتفكيك الدلالات الرمزية في النص السينمائي المرئي على المستويين التعييني (الظاهر) والضمني (المضمر) للمشاهد واللقطات من خلال شتى العناصر، بما فيها حركة الشخصيات، والإضاءة، وزاوية الكاميرا وحجم لقطاتها، وقد استخدمته لتحليل التمثيل الأيديولوجي للنساء في أفلام المخرجين الأمريكيين جون فورد وهوارد هوكس، الذين يصنفهما كثير من النقاد السينمائيين من بين أهم صناع الأفلام الكلاسيكية الأمريكية.
وفقًا لكلير، كانت المرأة في أفلام هوكس مصدر تهديد لوجود الرجال وصفته بـ«الحضور الصادم الذي يجب إبطاله للحفاظ على الرجال ووجودهم»، ولم تستثن منها فيلم «السادة الرجال يفضلون الشقراوات- Gentlemen Prefer Blondes» للممثلتين مارلين مونرو وجين راسل، الذي تنحو مؤخرًا العديد من الكتابات منحى مختلف في قراءته عبر عدسة نسوية، إذ تعتد به فيلمًا ذا نزعة نسوية في إطار نقده اتصالًا بالسياق الاجتماعي والسينمائي وقت صناعته.
وتبعًا لهذه القراءة التي تتعارض مع رؤية كلير جونستون، فإن ما يجعل الفيلم نسويًا بدرجة ما هو تمركزه حول امرأتين تجمعهن صداقة وثيقة، تتطلعان إلى استقلالهما المادي في عالم يملك الرجال فيه وحدهم المال، مما يدفعهما إلى التحايل عليهم لتحقيق هذه الغاية. في الوقت ذاته، يظهر معظم الرجال كخطر حقيقي على صداقتهما، ومع ذلك تتمسك كلتاهما بالحفاظ على متانة العلاقة بينهما، فتدعمان بعضهما ضد هؤلاء الرجال وتحميان بعضهما منهم، وهذه الصورة قلما كانت تظهر عليها العلاقات بين النساء في سينما هوليوود آنذاك، لأن الأكثر شيوعًا وقتها هو التصارع على الرجال، وحضور الرجل كأولوية قصوى في حياة الشخصية النسائية حتى إذا أثر وجوده سلبًا على علاقاتها الأخرى.
أما جون فورد، فقد توصلت كلير في تحليلها إلى أنه قد وظف المرأة في أفلامه كرمز للوطن والثقافة، لكي يعكس من خلالها علاقة الرجل وتناقضاته تجاه هذه الأمور ليس أكثر.

تعرج كلير أيضًا على نظرية التحليل الماركسي لتفسر رؤيتها للأفلام الكلاسيكية كمنتجات تعكس الأيديولوجية البرجوازية، المتحيزة ضد النساء، الخاضعة للهيمنة الرأسمالية الذكورية، وتعتبر أن المواجهة الناجعة لهذا التيار تتمثل في ممارسة سينمائية تكسر سطوة الرجال على صناعة الأفلام، وقد أطلقت عليها «السينما المضادة».
وتعبر كلير جونستون عن ثقتها بأن النساء سينجحن في خلق سينما مضادة، وسيكون بإمكانهن تقديم بديل للتيار التقليدي في هوليوود، إذا صنعن أفلامهن بوعي محتج على الأيديولوجية المتحيزة جنسيًا، حتى لو لم يظهر هذا التمرد صراحة في الفيلم وبرز فقط كأصداء تتردد في سرديته، وذكرت على ذلك مثالًا إيدا لوبينو، صانعة الأفلام التي امتهنت التمثيل، والإخراج، والكتابة، والإنتاج متحديةً الهيمنة الذكورية في هوليوود إبان الأربعينيات والخمسينيات، وقد أشارت كلير بالتحديد إلى فيلم «غير مرغوب – Not Wanted» الصادر في العام 1949، الذي شاركت إيدا لوبينو في كتابته وإنتاجه واضطلعت بإخراجه بعد اضطرار مخرجه الأصلي للانسحاب لظروف المرض، وهو الفيلم الذي قدمت من خلاله الأخيرة قصة أثارت جدلًا في المجتمع الأمريكي آنئذٍ، لتناولها مسألة اختيارات المرأة الشخصية والجنسية، فضلًا عن قضية الحمل خارج إطار الزواج وتبعاتها على النساء.
تدور القصة حول امرأة عشرينية ليست على وفاق مع أسرتها التي تريدها نموذجًا للفتاة المحافظة كي ينتهي بها الحال زوجة لرجل «محترم». أما هي فترى الحياة بعين مختلفة، فيها موسيقى الجاز هي المحرك الرئيس لشغفها وأحلامها، والسبب وراء علاقتها العاطفية والجنسية بأحد عازفي البيانو، التي سرعان ما تنتهي بينما تحمل في أحشائها جنينًا لم ينمو داخلها نتيجة علاقة زوجية تقليدية مقبولة اجتماعيًا.
تجد الشخصية الرئيسة نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتها بالجنين الذي ترغب في إبقائه معها بعد الولادة، لكنها تدرك تمامًا أن هذا الخيار سيضعها في مرمى نيران الوصم مما سيترتب عليه كره طفلها أو طفلتها لها، ولذلك تقرر ترك مولودها للتبني، ومن هنا تدخل في دوامة من الشعور بالذنب والاضطراب النفسي نتيجة الضغوط الاجتماعية التي أجبرتها على سلك هذا المسلك.
لورا مالفي: عيون البطل والمُشَاهِد تتلصص على المرأة
المقالة الثانية التي تعد مرجعًا أساسيًا في التحليل النسوي للأفلام ودراسة نظرية الفيلم النسوي، كتبتها الأكاديمية والمخرجة البريطانية لورا مالفي ونشرتها كورقة بحثية في خريف العام 1975 تحت عنوان «المتعة البصرية والسينما الروائية»، وقد انطلقت فيها من نظرية التحليل النفسي لفك شفرة اللا وعي الأبوي الذي يقف وراء الأفلام الكلاسيكية المصنوعة في هوليوود، وتنطلق لورا في بنائها التحليلي مما عرّفه سيجموند فرويد بـ«لذة النظر – Scopophilia»، وهي الحالة التي يكون فيها التلصص والمراقبة من مسببات الشعور بالمتعة لدى الفرد، بما فيها المتعة الجنسية.
وعملًا بهذه الفرضية، تحاجج لورا بأن السينما تحقق المتعة البصرية عن طريق استراق النظر إلى شخصيات الأفلام، مشبهةً الشاشة بالمرآة التي يتماهى من خلالها المشاهد الجالس في القاعة المظلمة في شخصية البطل، بينما تتأمل عيناه النساء بنظرة شهوانية نتيجة توظفيهن في أفلام «التيار المركزي» في هوليوود كموضوع جنسي يحقق اللذة البصرية على مستوى الشخصيات الذكورية في الفيلم وعلى مستوى المشاهد الذكر في الوقت نفسه، وقد استحدثت لورا مالفي في هذا السياق مصطلح «تحديقة الذكر – Male Gaze»، لوصف التصوير البصري للنساء على الشاشة السينمائية كأشياء تثير الشهوة الجنسية لدى الرجل المغاير جنسيًا.
وتستدل لورا على فرضيتها باللقطات التي تتبع مارلين مونورو في بداية ظهورها في فيلم «نهر اللا عودة – The River of No Return»، وتلك التي تصور لوران باكال أثناء أدائها للأغاني في فيلم «ليكن لديك وليس لديك – To Have and Have Not»، وهي تستعرض جسميهما على نحو يستثير التأمل الجنسي لدى المشاهدين.
وبينما كانت السينما المضادة هي الحل لمقاومة هذا التيار من وجهة نظر كلير جونستون، رأت لورا مالفي أن السينما الطليعية البديلة التي تتمرد على الفيلم بمتعته التقليدية هي السبيل لخرق ما هو سائد في هوليوود.

تقترب مقالة «المتعة البصرية والسينما الروائية» من إتمام خمسين عامًا على نشرها، وقد ظلت على مدى الفترة الماضية سندًا في معظم التحليلات والقراءات النسوية للأفلام والكثير من منتجات الفنون البصرية، لا سيما فيما يتعلق بفرضيتها بشأن «تحديقة الذكر»، بيد أن إشكاليات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها فيما طرحته لورا مالفي، ومنها على سبيل المثال؛ استبعاد وجود المشاهدة النقدية للأفلام حتى من جانب النساء، فالإطار النظري الذي تضعه يرتكز إلى افتراض بأن جميع من يشاهدون الفيلم سيتشربون الأيديولوجية التي يحملها من دون أي شكل من أشكال المقاومة. علاوة على ذلك، تختزل لورا في مقالتها «الرجل المحدّق» في الذكر الأوروبي، الأبيض، المغاير جنسيًا، فلا مكان لنظرة صاحبات وأصحاب البشرة السمراء والسوداء، أو للنظرة غير الخاضعة للاستعمارية الثقافية، أو نظرة الأقليات الجندرية.


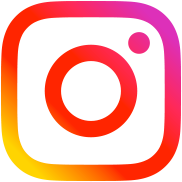





 by
by