للتنشئة الأسرية والاجتماعية بصمتها.. بُعدٌ آخر لأزمة تكبُّد النساء أثمانًا استثنائية كلما وقعت كارثة طبيعية
يشهد مؤشر الكوارث الطبيعية تصاعدًا لافتًا على مستوى العالم، وعلى وجه الخصوص الكوارث المرتبطة بالمناخ (مثل: الجفاف والفيضانات والعواصف) التي يتواصل اتجاهها التصاعدي منذ أربعينيات القرن الماضي. وفي العام 2022 وحده، وقع ما يقرب من 388 كارثة طبيعية، وهو أعلى من المعدل المعتاد خلال الفترة من 1991 وحتى 2021، الذي انحسر في 340 كارثة سنويًا على المستوى العالمي.
إذا اجتاحت كارثة طبيعية مكانًا ما، وكانت النجاة حليفة بعض من يمكثن ويمكثون فيه، فإن نجاتهم تظل منقوصة، فما من أحد لن تلفحه أهوال الفيضانات والأعاصير عند وقوعها، ولو مر الزلزال من دون خسائر مادية كبرى فلا مفر من الصدمة والذكريات القاتمة التي ستختزنها العقول لسنوات طوال، ومن المحال أن تخمد ثورة البركان من دون آثار جسام على كل من في الجوار، وإذا ضرب الجفاف أرضًا فإن الحياة عليها لا بد أن تتحول إلى شقاء يومي.
حين تحل الكارثة الطبيعية بأرض، تغدو المعاناة والخسارة أمرين محققين وثابتين في كل مرة، لكن حجم الخسارة وشكلها ودرجة المعاناة وأمدها لا تختلف فقط من كارثة إلى أخرى، وإنما تتفاوت بين الجماعات والأفراد المتضررين من الكارثة نفسها، وحتى مسار التعافي من تداعيات الفجيعة لا يكون موحدًا أمام الجميع، إذ تتعدد المسارات وتختلف مسافاتها بناءً على عوامل عديدة، ولعل العامل الاقتصادي هو صاحب اليد الطولى في شتى الكوارث على مختلف الصُعُد، سواء الفردية أو الجماعية أو القومية.
ويمكن استجلاء ذلك عند النظر في حالة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير من العام 2023، فقد بدت الفجوة في الاستجابة إليه واسعةً للغاية بين كلا البلدين، كما أن إعادة الإعمار ومساعي التعافي لم تمض بالوتيرة ذاتها، فقد جاء الزلزال ليفاقم المعاناة الإنسانية القائمة بالفعل في الشمال السوري منذ ما يزيد عن عشر سنوات، بينما ساهمت الإمكانيات الاقتصادية للدولة التركية – وهي أفضل كثيرًا من تلك المتاحة في سوريا – في تقصير مدة إزالة الحطام والإسراع في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تزويد المواطنات والمواطنين بحزم من الدعم والتعويضات لم يتلقاها نظرائهم في الشمال السوري.
علاوة على ذلك، لم تكن التداعيات متقاربة حتى في داخل تركيا، فقد اختلفت من منطقة إلى أخرى تبعًا لمدى جاهزيتها لاستيعاب مثل هذه الصدمات، ووضع بنيتها التحتية، ومدى توفر الخدمات الصحية اللازمة للحد من الخسائر البشرية، وهو الحال الذي عرفته المغرب في سبتمبر من العام 2023، حين ضرب زلزال شديد القوة عددًا من المناطق والأقاليم المغربية، إذ كانت خسائر سكان القرى أكبر بكثير من تلك التي تعرض لها سكان المدن، نتيجة التهميش الذي تعانيه المناطق القروية المغربية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وضعف التغطية الصحية، وارتفاع معدلات الفقر والأمية بين سكانها.
بالإضافة إلى الاقتصاد، هناك العوامل الاجتماعية والثقافية التي يتحدد على إثرها مدى استعداد الأفراد والمجتمع للكوارث الطبيعية، فالوعي بالمخاطر يتصل بالقدرة على الوصول إلى الموارد ذات الصلة التي تتباين وفقًا لمستوى التعليم، والقدرة الجسدية (الإعاقة)، والحالة الوظيفية، والموقع الجغرافي. وكانت إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية التابعة للكونغرس الأمريكي قد ذكرت في نشرتها الصادرة في يوليو من العام 2017، أن واحدة من الدراسات التي استهدفت الناجيات والناجين من إعصار ايك الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية في العام 2008، جاءت نتائجها لتؤكد أن أولئك الذين حصلوا على عدد سنوات تعليم قليلة (بحد أقصى التعليم الثانوي أو ما يعادلها) كانوا الأكثر تضررًا نفسيًا وإصابة بالاكتئاب، فضلًا عن أنهم كانوا أكثر عرضة بمقدار الضعف للبقاء في أماكنهم في أثناء الكوارث، ممن نالوا درجات أعلى في التعليم وبالتالي العمل.
يتوجه الجانب الأكبر من الدراسة والتحليل الذين يجري إعدادهما لقياس تأثير الكوارث الطبيعية إلى العاملين الاقتصادي والاجتماعي، ورغم أهمية تقييم الحوادث العظمى من هذه النواحي، فإن نزعَ البُعدِ الجندري عنها يجعل تطوير آليات الاستجابة بناءً عليها قاصرًا، ويصبح من غير الممكن أن يكون تضييق الفجوة في التأثير والدعم والتعافي هو النتيجة، لأن هذه العملية الطامحة إلى تقليل الضرر على مستويات عديدة لم تكن متحسسة تجاه التمايز في خبرات الأفراد الناجم عن اختلاف نوع الجنس، وهي الحقيقة التي أثبتها البحث الميداني عقب عدد من الكوارث العظمى التي طالت أنحاء متفرقة من العالم، بعضها في دول متقدمة أكثر استعدادًا وتهيؤًا لمثل هذه الطوارئ، وأخرى في دول ذات إمكانيات ضعيفة وهشة.
تأتي كل من كلية لندن للاقتصاد وجامعة إسيكس ومعهد ماكس بلانك لعلم الأرض الجيولوجية، بين الجهات البحثية التي أثبتت أن الكوارث الطبيعية ليست محايدة جندريًا في تأثيرها وتبعاتها، من خلال دراسة مشتركة صدرت في العام 2008 تحت عنوان «الطبيعة الجندرية للكوارث الطبيعية»، استندت نتائجها إلى رصد دقيق للكوارث الطبيعية التي ضربت 141 دولة في الفترة من العام 1981 وحتى العام 2002، تبعه تحليل لتأثيرها الاجتماعي من زاوية مراعية لنوع الجنس.
جاء من بين أهم مخرجات دراسة «الطبيعة الجندرية للكوارث الطبيعية» الكشف عن الفارق الكبير في أعداد الوفيات بين النساء عنها بين الرجال، والعلاقة بين الحالة الاقتصادية للنساء وحجم التأثير السلبي عليهن، فقد بينت الدراسة أنه إذا كان وضع النساء الاقتصادي سيئًا تفاقمت تبعات الكارثة عليهن، وإذا كان جيدًا انحسرت خسائرهن، بما يؤكد حقيقة التأثير المركب للتقاطع بين الخصائص المختلفة لكل امرأة.
الظروف والتوقعات الاجتماعية توسّع فجوة الضرر بين الجنسين
في تسعينيات القرن الماضي، عرفت الهند واحدًا من أعنف الزلازل في تلك الحقبة، وهو زلزال لاتور الذي ضرب ولاية ماهاراشترا، وكان سببًًا في تدمير نحو 52 قرية عن بكرة أبيها، ومقتل عشرة آلاف وإصابة ثلاثين آلفًا. وقد أوضحت بيانات الضحايا والناجين بعد فصلها على أساس الجنس أن معدل الوفيات بين النساء كان أعلى منه بين الرجال بشكل لافت، ثم عادت وتجلت الإشكالية ذاتها في بداية الألفية الثالثة بعد تحليل البيانات المجمعة بشأن الضحايا والناجين من الزلزال الذي ضرب ولاية غوجارات الهندية، إذ كانت النساء والفتيات يمثلن النسبة الأكبر من الضحايا الذين قُدِرَت أعدادهم بين 13 ألفًا إلى عشرين ألفًا، وكذلك الناجين الذين تجاوز عددهم 160 ألفًا.
وبعد عدة سنوات، وتحديدًا في العام 2004، نالت الهند نصيبًا من تسونامي المحيط الهندي الذي أعقب زلزال سومطرة، ثالث أقوى زلزال العالم والذي دمر مناطق شاسعة في 12 بلدًا، لكن تأثير التسونامي الأضخم والأقسى كان من حظ إقليم آتشيه غرب إندونيسيا، ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة أوكسفام الدولية فقد فاق عدد الناجين الذكور من التسونامي عدد الناجيات بنسبة 3:1، أي أن النساء والفتيات مثلن ثلاثة أرباع الضحايا.
تجاوزت نسبة النساء بين الضحايا في بعض الكوارث الطبيعية الـ90 في المئة، مثلما كان الحال حينما ضرب بنغلاديش في العام 1991 واحدًا من أكثر الأعاصير المدارية فتكًا.

أظهرت الدراسات الميدانية اللاحقة على هذه الكوارث أن ثمة سبب مشترك يقف وراء الفجوة العميقة في التأثير على الجنسين، خاصةً فيما يتعلق بخسارة الأرواح والإصابات الجسدية، وهذا السبب هو الأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تجعل النساء يقضين معظم أوقاتهن داخل البيوت كراعيات لأفراد الأسرة، وكذلك التقاليد التي تقيد حركتهن خارج المنزل مكانيًا وزمانيًا، بينما يقضي الرجال القسم الأكبر من اليوم إما يعملون داخل مبان غالبًا ما تكون حالتها أفضل من حال منازلهم وإما يتنقلون من مكان لآخر بحرية كاملة.
كما تكشف الباحثة والصحافية الهندية شروتي تشوكسي أن الأدوار الجندرية تعطي الرجال الأحقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة فرادى، بما فيها قرارات إخلاء المنازل قبيل وقوع الكوارث في حال صدرت إنذارات مبكرة بشأنها، ومن ثم تنتظر كثير من النساء قرارات ذويهم الرجال لترك المنزل والمنطقة المعرضة للخطر، إلا أن هذه القرارات قد تتأخر أو لا تأتي من الأساس.
من ناحية أخرى، توضح دراسة منظمة أوكسفام حول تأثير تسونامي المحيط الهندي على النساء أن أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى الفارق الكبير في أعداد الوفيات بين الذكور والإناث، كانت القدرة على السباحة وتسلق الأشجار وهي مهارات تهتم العائلات بإكسابها للأطفال الذكور حصرًا، وتقول شانتي سيفاسانا المساعدة بإدارة البرامج بالمنظمة إن «الكثير من الرجال في سيريلانكا تسلقوا الأشجار هربًا من الأمواج العاتية، وهو شيء اعتادوا على فعله سواء عندما كانوا أطفالًا يلعبون أو عندما صاروا كبارًا يشتغلون بقطف وجني الفواكه، لكن النساء لم يفعلن مثلهم لأنهن لا يعرفن كيفية القيام بذلك.»
فيما بين يوليو وسبتمبر من العام 1998، تعرضت بنغلاديش إلى فيضانات كانت الأشد والأطول في القرن العشرين، وأسفرت عن انغمار أكثر من 75 في المئة من مساحة البلد بالمياه، ولذلك لجأت أعداد كبيرة من السكان إلى الاستقرار بمخيمات في مناطق نائية، مما أدى إلى افتقاد النساء والفتيات إلى الخصوصية، وحرمانهن من التمتع بمساحات شخصية وهو ما كان له أثره على صحتهن النفسية والجسدية. وقد أوضحت ورقة بحثية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان «المراهقات وجنسانيتهن: مفاهيم الشرف والعار والعفة والدنس في أثناء الفيضانات»، إن الكثير من المراهقات البنغاليات اللاتي عايشن هذه الظروف، لم يكن سهلًا عليهن النوم أو الاستحمام أو استخدام المراحيض بسبب الخوف والقلق من محاوطة الرجال لهن، كما أن بعض الفتيات لم يكن قادرات على الحفاظ على نظافتهن الشخصية، لا سيما في أوقات الحيض التي تعدُ من أكبر التابوهات المرتبطة بأجسام النساء، وقد أرجعن ذلك إلى الخجل من غسل ملابسهن التي تغطيها بقع الدم أمام الرجال الغرباء الذين يرقبونهن، ولهذا كن يقضين ساعات طويلة من دون أن يغيرن ملابسهن والفوط الصحية القابلة للغسل وإعادة الاستعمال، إلى أن يأتي منتصف الليل حين يسود الهدوء وتخفت الحركة، فيذهبن نحو مياه الفيضان المتراكمة التي يعلمن بتلوثها ويغسلن ملابسهن، إذ لم تترك لهن ندرة المياه النظيفة في المخيمات خيارًا آخر.

تربط الورقة البحثية بين جزء من المعاناة التي عاشتها المراهقات في ذلك الوقت، وأسلوب العائلات البنغالية في تربية الفتيات الذي يعمد إلى ترسيخ شعور داخلهن بالخجل من أجسامهن. وتذكر ورقة الأمم المتحدة للمرأة أن جميع الفتيات المستطلعة آراؤهن أفدن بأن الخوف من انكشاف أجزاء من الجسم والخجل من حدوث ذلك أمام الذكور، هي سمات أساسية لـ«الفتاة العفيفة» التي تحظى باحترام عائلتها والمجتمع المحيط بها.
تشابكت الممارسات غير الصحية التي اضطرت إليها المراهقات في خلال فترات الحيض مع خجلهن من أجسامهن التي تربطها بهن علاقة مضطربة يغمدها الخوف من المجتمع، فانتشرت بينهن الإصابة بالتهابات المسالك البولية والطفح الجلدي حول المهبل، ومع ذلك امتنع كثير منهن عن الذهاب إلى مرافق الخدمات الصحية استحياءً من مناقشة أمر له علاقة بالحيض أو منطقة العجان (ما بين فتحة الشرج والمهبل) مع الأطباء الذكور، وتعزي الورقة البحثية ذلك إلى الموقف الاجتماعي المتحفظ تجاه ذهاب المرأة غير المتزوجة إلى الأطباء الذكور، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمشاكل المتصلة بالصحة الجنسية.
في كل ما أوردناه من حوادث، أعطت الأعراف الاجتماعية والثقافية دفعة للكوارث الطبيعية كي تعمّق الفجوة بين الجنسين وتضخم معاناة النساء والفتيات وخسائرهن، ولولا إضافة البُعد الجندري في قراءة وتحليل هذه الكوارث ما أزيل اللثام عن الالتحام القوي بين الثقافة المجتمعية والتنشئة الأسرية في المجتمعات الأبوية من ناحية والأزمات الطارئة من ناحية أخرى، وما ازدادت المعرفة بدوره في قمع النساء وانتزاع حقوقهن بما فيها الحق في الحياة.
لكن هذه الحقائق التي أثبتها البحث والدراسة على مدى عقدين ونيف، يبدو أن الحكومات والمؤسسات الدولية لا تكترث إليها أو لا تأخذها على محمل الجد، إذ لا يزال النصيب الأكبر من خسائر الكوارث الطبيعية تتكبده النساء والفتيات، بسبب استمرار هيمنة العمى الجندري على الاستراتيجيات الوطنية والدولية في التعامل مع الأزمات الطارئة.


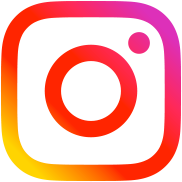





 by
by