«يوم للستـــــات».. يوم لتحرير الروح من الهموم والجسد من القيود
حيث الفقر المدقع نعيش ما يقارب الساعتين، مع شخصيات متباينة، تجمعهم المعاناة، والعمر الضائع وسط ركام المشقة والهموم، متمزقين بين انفلات غير معلن وتزمت مُشهر، نتغلغل في دواخل نساء مكبلات بقيود الرجال المفروضة باسم الذكورية تارة واسم الدين تارة أخرى، حتى أصبحت ملامسة الماء لأجسادهن وسباحتهن في حمام محدود المساحة، هي الحرية التي تصبو أرواحهن إليها.

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفيلم «يوم للستات» للمخرجة “كاملة أبو ذكري”، مرتين الأولى مع عرضه خلال حفل الافتتاح والثانية في عرضه الثاني ضمن عروض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية الدولية، وقد أضاف رونقًا خاصًا للمهرجان بعد أن أعاد الصبغة المصرية لتقليد “فيلم الافتتاح” بعد غياب دام لسنوات، وأضاف للسينما مُنتجًا فنيًا انتشل من الواقع قصصًا تحكي عن القهر الذي تقاسيه النساء في ظل الفقر والتطرف والذكورية.
يرصد الفيلم الذي كتبته “هناء عطية” في ثاني تجاربها السينمائية بعد “خلطة فوزية”، قصص ثلاث نساء ينتمين للطبقة الشعبية الفقيرة، تعاني كل منهن من ثمة استغلال وانتهاك من قبل المجتمع المحيط، وتدور الأحداث في فترة تسبق ثورة الــ25 من يناير، وعلى الرغم من أن صانعات الفيلم حاولن قدر الإمكان الابتعاد عن السياسة، إلا أن إرهاصات تعفن النظام وغليان المجتمع بدت جلية.
نساء تتوق نفوسهن إلى الحرية
نقطة البداية عند “عزة” وتؤدي دورها “ناهد السباعي”، الفتاة التي تعاني من تأخر ذهني، وتتطلع بشغف إلى أن تتذوق حرية السباحة، مثلها مثل الصبية والرجال في حمام السباحة الذي أقامته وزارة الشباب بمركز الشباب الموجود بالمنطقة.
المشاهد الأولى تفصح عن عدم إدراك “عزة” لكثير من الأمور التي تجري حولها وعواقب تصرفاتها، ولأن التلقائية هي التي تقودها فيسهل خداعها، لدرجة جعلتها تصدق أن الثراء الفاحش والطعام الفائض ليس في مصر التي تعيش فيها بل في «مصر الثانية»، وتنكشف حالة العنصرية التي يمارسها بحقها أهل الحارة، بتسميتها بــ”عزة العبيطة”، وملاحقة الصبية لها بالسب والضرب، ومحاولة الشخص الذي يرتدي عباءة التدين والالتزام، الاعتداء عليها جنسيًا، وعندما قاومته افترى عليها القول، مدعيًا أنها سبق وفعلت ذلك مع غيره، يقينًا منه أن الناس ستصدق “الشيخ” وتكذب “العبيطة”، في المقابل تشملها نساء الحارة برعاية هي وجدتها التي تعيش معها منذ توفي والديها في حادث أثناء ركوبهما دراجة بخارية.
“عزة” هي أكثر النساء ابتهاجًا بحمام السباحة الجديد، وأكثر النفوس تشوقًا لمعانقة مياهه، فهي من بادرت بشراء مايوه، وأول من افتتح يوم الستات، وتمكنت مخرجة الفيلم من نقل حالة التناغم التي تولدت بينها وبين الماء، وشعورها بالتحرر من كل الدنس المعنوى والمادي الذي يلاحقها في هذا العالم.
أما شخصية “ليلى” التي تؤدي دورها “نيللي كريم”، فهي الأم المكلومة بعد أن فقدت ابنها الوحيد وزوجها في الحادثة الأبشع “عبارة السلام 98” التي وقعت في عام 2005، وراح ضحيتها أكثر من ألف مسافر كانوا على متنها.
وشخصية “ليلى” تحديدًا هي أكثر الشخصيات التي لم تٌرسم بإحكام على مستوى الكتابة والإخراج، إذ طغت حالة الحزن الشديدة الممتزجة بصمت طويل إلى حد غيب تفاصيل كثيرة عن الشخصية، فلا مجال للتعرف عليها أكثر، فضلًا عن أن أغلب مشاهدها ظهرت فيها مُستمع صامت لشخصية “شامية” التي تؤدي دورها “إلهام شاهين”.
وبدون تفاصيل محكمة أيضًا، يتضح أن شقيقها المتشدد -أحمد الفيشاوي- يمارس تجبره تحت اسم الرقابة الدينية، ويلومها على وقوفها في محل لبيع العطور، ويأمرها بالابتعاد عن صديقتها “شامية” المعروفة بسوء سمعتها في الحارة.

“ليلى” لم تفقد ابنها وزوجها فحسب، ولكن فقدت قبلهما الحبيب “بهجت” ويؤدي دوره “إياد نصار”، الذي سافر للعمل بالخارج لتحسين ظروف معيشته البائسة، وفي غيابه تم تزويجها من رجل متقدم في السن، ثم سافرت معه إلى السعودية حيث يعمل وانجبت ابنها.
وفي ظل العتمة الموحشة التي تخيم على الروح القابعة خلف أسوار الاَلم، يظهر “بهجت” محاولًا إعادة وصل الحاضر بالماضي الذي عاندته الظروف، وينجح بالفعل في إعادة البسمة على وجهها.
السلطة الأبوية التي عرفتها “ليلى” طيلة حياتها مع أبيها وأخيها، لا تشعر بالتحرر منها سوى في حمام السباحة، حيث تتحرر من كم هائل من الغطاء تتلفع به، وتترك جسدها تتسلل إليه أشعة الشمس المحروم منها، ويطوقه الماء فيخلصه من همومه.
الحبيب الذي حالت الظروف دون الاستمرار معه، هي أزمة مشتركة بين “ليلى” و”شامية”، إلا أن الفقر ليس السبب كما هو الحال مع الأولى، بل المهنة وتاريخ الأسرة هما السبب، فقد نشأت “شامية” في كنف أم وخالة تعملان “موديل” للرسامين، وورثت المهنة نفسها، فصارت تُرسم عارية منذ بلغت الــ13، لكنها على عكس أمها خشيت أن تنجب طفلًا أو طفلة لا تعلم من والده بين الرسامين، فحافظت على عذريتها، ومع ذلك فظنون أهل الحارة ألبستها ثوب العُهر، وظلت في نظرهم بما فيهم والدي الحبيب “أحمد” الذي يؤدي دوره “محمود حميدة”، امرأة ساقطة من المحال أن يتزوجها ابنهما.
يستسلم “أحمد” لأمر والديه ويتزوج بأخرى، ومن ثم يسافر إلى الخليج مثل كثير من أبناء الحارة، وتمضي الحياة ويصبح أبًا لابنين، بينما تبقى “شامية” على حالها؛ موديل، عذراء، عاهرة في عيون الاَخرين، ويستوطن هو قلبها وحيدًا.
وعلى الرغم من كل الوجع الذي تكتسي به “شامية”، تجد في مياه حمام السباحة مهربًا منه، وتذوب النظرة الدونية تجاهها عندما تتشارك مع النساء في تلك المساحة الصغيرة، ومع ذلك قد يبدو التعاطف الذي أظهرته النساء تجاهها، عندما عبرت عن معاناتها مع الحبيب غير مقنعة أو قابلة للتصديق، في ظل بيئة محافظة، يعتبرها كل من فيها عنوان الفجور.
لحظة كسر الحصار الخانق للحرية
الإبداع يتجلى في ذلك المشهد، الذي تتقدم فيه النساء بإتجاه حمام السباحة لأول مرة، ليخلعن أمامه حجابهن والطرح التي تغطي رؤسهن، وتنعقد على رقابهن، ومع كل طرحة تلقى فوق الأخرى، تتحرر امرأة بعد الأخرى من الأغلال التي تكبل نفوسهن وأجسادهن، والعكس تمامًا نراه عندما ينتهي اليوم، وتقف كل امرأة أمام المراَة، تتأكد من ربط الطرحة، وتغطية كل خصلة من شعرها، حتى تتمكن من الخروج إلى ذلك العالم الذي يكبح جماح حريتهن.
التمرد محدود وعلى استحياء
على الرغم من أن جميع الشخصيات النسائية في ظاهرها، منسكرة ومهزومة، إلا أن كل منهن تملك داخلها قوة وتمردًا، يظهران في مواقف ويغيبان في أخرى، وذلك ليس مستغربًا في المجتمعات التي تجد فيها الذكورية مرتعًا.
وكما تستسلم “ليلى” لبطش أخيها وكلامه المسموم في أغلب الأحيان، نجدها تنتفض وتنهره وتمتنع عن إجابة أمر له، وكذلك “شامية” التي على الرغم من استسلامها لحبيب تخلى عنها لضعف شخصيته وعدم قدرته على مواجهة المحيطين، إلا أنها تتمرد على المجتمع المحافظ، وتجلس في وسط الحارة تدخن السيجارة التي تمتص الحرائق المشتعلة بداخلها، ولا تصغي لأي تحريم أو تحذير.
أما “عزة” التي تمضي أحداث الفيلم وهي الأضعف والأكثر رضوخًا لبطش المجتمع، تتمرد أخيرًا على مخاوفها من الدراجة البخارية التي كانت سببًا في فقدانها لأبويها، وتستقلها مع حبيبها “إبراهيم” الذي يقوم بدوره “أحمد داوود” وتحلق معه بالروح والجسد، لتكتشف أن للحرية دروبًا أخرى غير حمام السباحة.


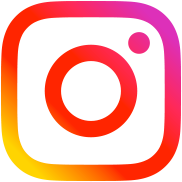





 by
by