إشكاليات الرجولة: الذكوريـة السامة يردفها عنف هائل ضد النساء
«كانت أمي تخشى من قول كلمة “لا” لوالدي لأنها تغضبه بشدة، رغم أنه يقبلها من مديره في العمل، وصاحب العقار الذي نسكن به، وشقيقه وأبيه، وهو نفسه يقولها كثيرًا، لكنه لا يقبل أن تقف أمي أمامه وتعلن رفضها بـ”لا”. كان يريدها دائمًا أن تقول نعم، وإذا لم تقلها تضطر إلى الاعتذار مرارًا عن ذلك وتتودد له حتى لا يثور غضبًا، فكلمة “لا” بالنسبة له تعني أن المرأة التي يعتبرها ملكًا له، طيعةً له، تابعةً له، لم تعد أي شيء من ذلك، بعد أن رفضت بشكل صريح ومباشر ما قرره أو أراد فرضه عليها.»
«حينما كنت بالجامعة ارتبطت عاطفيًا بزميل لي، كان لا يحب مطلقًا أن أتحدث إلى النادلين الذكور في المطاعم والمقاهي طالما أنه معي، وكلما أردنا أن نستقل سويًا التاكسي كان يحذرني من التحدث إلى السائق في وجوده حتى لا ينتقص ذلك من رجولته، وكان يفرض علي نمطًا بعينه من الملابس، وإذا صممت على ارتداء شيء لا يعجبه يخاصمني أيامًا، وحين انتفضت على كل هذا وجدته يدافع عن نفسه، بأنه لو لم يتصرف على هذا النحو لن يكون رجلًا في عيون شخصه أو من يحيطون بنا أو حتى أنا.»
«سمعت زميلتي بالعمل ذات مرة تتباهى أمام اثنتين آخريين بأنها قد ربت رجلًا، لأن ابنها يعرف كيف يؤدب شقيقتيه “عند اللزوم”، والأسوأ هو أنها كانت في غاية السعادة بتقييده لحياة شقيقته التي تكبره بست سنوات بما يتماشى مع التقاليد الاجتماعية، لأن هذا بالنسبة لها دليل دامغ على أنه رجل بمعنى الكلمة و”بيعرف يمشي كلامه على أخواته البنات”، وهذا هو المنتظر من الرجل كما يجب أن يكون وفقًا لها.»
تؤكد هذه الشهادات أن الشعور بالهيمنة والاستحواذ يتشكّل داخل الذكور منذ الطفولة، ليصبح فيما بعد أمرًا بديهيًا وطبيعيًا وأي مساس به هو تهديد لوجودهم، ومن ثم يكون العنف سلاحًا أساسيًا في جعبتهم ليحافظوا على رجولتهم أمام المجتمع. هذا العنف يصـل أحيانًا إلى القتل.
خلال الأشهر الماضية، شهدت مصر تدافعًا في جرائم القتل المُؤجج بشعوري الهيمنة والاستحواذ الذكوريين، إذ لم يتحمل أي من مرتكبيها أن ترفض امرأة الارتباط به، أو أن تقرر إنهاء علاقتها به، انطلاقًا من اعتقاد استقر داخلهم بأن الرجل يرفض ولا يُرقَض ويكتب النهايات ولا تُكتَب له.
وقعت أول هذه الجرائم في شهر يونيو الماضي أمام جامعة المنصورة، في وضح النهار على مرأى ومسمع من عشرات المارة، وكان السبب وراءها هو أن نيرة أشرف المغدور بها قد قالت لأحد هؤلاء «لا» وأصرت على قرارها الحر، ثم لحقت بها للسبب ذاته سلمى بهجت، وما هي إلا أسابيع معدودة حتى أدركتهما أماني الجزار، وفي الحوادث الثلاث برزت الحساسية المفرطة تجاه رفض الرجل كحبيب أو شريك أو زوج كدافع وراء القتل، إلا أن ذلك لم يكن في حقيقة الأمر سوى تمظهرٍ للذكوريـة السامة التي تحكم الرجال في أفعالهم وأقوالهم، ويحميها مجتمع يتساهل مع الدفاع عن هؤلاء القتلة ويفتح ذراعيه أمام المسوغات المُختلَقة لتبرير جرائمهم، كإدعاء أن الضحايا قد نلن من كرامة «رجال» وجرحن كبرياءهم، وهو ما أدى إلى استنهاض الغضب داخلهم، فألجأهم إلى العنف لدفع العار الذي لحق بهم.
الذكوريـة السامة.. كضمانة للبقاء في قمة الهرم الأبوي
يمكن تعريف الذكورية بأنها حزمة من الأفكار والأدوار والسلوكيات يتوقعها المجتمع من الذكور، وهي نتاج ثقافةٍ تشكّلت عبر قرونٍ طويلة وتوارثتها الأجيال تحت مظلة نظام هرمي، لا يُسمَح لغير الذكر الملتزم بهذه التوقعات أن يعتلي قمته، وإذا لم يحقق المنتظر منه فسيعاقبه المجتمع بنزع سمة «الرجولة» عنه، بما يعني فقدانه لامتيازات التفوق والهيمنة.
تدجن المجتمعات الأطفال بـ«الذكورية» من خلال التربية، والتعليم المدرسي، ووسائل الإعلام، والمنتجات الدرامية، لتبدأ تمثلاتها في الظهور خلال مرحلة المراهقة، ومع الانتقال إلى مرحلة الشباب يصبح الذكر أسيرًا لهذه التصورات، وكلما تقدم في العمر تغدو الصور النمطية أكثر رسوخًا في شخصيته.
في معظم المجتمعات يتعين على الذكور صغارًا وكبارًا أن يتصفوا بالقوة، والصلابة، والجرأة، والعدوانية أحيانًا، والنشاط الملحوظ، والعقلانية، وأن لا يكونوا عاطفيين، ولا ينفتحوا في التعبير عن مشاعرهم إلا إذا كانت مشاعر غضبٍ وثورة وليست مشاعر حب واحتياج وحزن.
تنعكس هذه الصفات في سلوكيات كالعنف الجسدي أو الجنسي، ومواقف كإزدراء المرأة وتشييئها، ومشاعر كالاستحقاق للسلطة والهيمنة خاصةً على النساء، وقد اصطُلِحَ على هذه الحالة باسم «الذكورية السامة – Toxic Masculinity»، ويأتي وصف الذكورية بـ«السمّية» لأن تأثيرها المتفاوت يبدأ من تلف وضرر يصعب التعافي منهما، ويصل في كثير من الأوقات إلى القتل سواء كان معنويًا أو ماديًا.
من جانبها، تُعرّف الصحافية والناشطة النسوية أماندا ماركوت الذكورية السامة بأنها «نموذج مُحدِّد للرجولة، موجّه نحو الهيمنة والسيطرة التي تنظر إلى المرأة باعتبارها أقل شأنًا، وترى الجنس على أنه فعل – ليس فعلًا عاطفيًا – بل فعل هيمنة، وهو النموذج الذي يقيّم العنف كوسيلة لإثبات الذات أمام العالم.»
أما الباحثة الأمريكية ليلي كاثرين ثاكر فقد عمدت في دراستها «خطر “لا”: عنف الرفض، الذكورية السامة، والعنف ضد النساء»، إلى إثبات العلاقة المباشرة بين الذكورية السامة والعنف ضد المرأة الذي يبلغ القتل أحيانًا، مشددةً على أن الذكورية المهيمنة تكرس العداء تجاه المرأة لتعزيز سطوة الرجل، وهو ما يخلق شعورًا لدى الرجال بأنهم ليسوا فقط مستحقين للنساء جنسيًا وعاطفيًا، وإنما بأنه من المنصف لهم أن يردوا على «الرفض» بالعنف. كما تجادل ليلي بأن الرجل يرتكب هذا العنف في محاولة لاستعادة مكانته كـ«رجل حقيقي» يؤدي دوره الذكوري بنجاح.
من محاولة للتحايل على الواقع إلى أداة لتحليل الواقع
«الذكوريـة السامة» كمصطلح لم يُصاغ داخل الأوساط النسوية ولم يكن في البداية واضحًا بهذا القدر، وإنما بدأت إعادة النظر في تعريفه وتجديد استخدامه على أيدي أكاديميات نسويات منذ العام 2013، بينما يعود الظهور الأول للمصطلح إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما برزت في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعات من الرجال، عُرِفت باسم «حركة الرجال الأسطورية – Mythopoetic Men’s Movement»، تهدف إلى دعم الرجال نفسيًا وخلق دوائر آمنة لهم تساعدهم على أمرين رئيسين هما: حماية هويتهم كذكور، وتجاوز الجزء السيء في النفس الذكورية الذي يؤذي النساء، والأطفال، والرجال أيضًا لا سيما هؤلاء الذين يفتقرون إلى الامتيازات الطبقية والعرقية.
لم يكن الكاتب الأمريكي شيبيرد بليس الذي صك المصطلح، يريد أن يلخص من خلاله أزمة الثقافة الذكورية، أو أن يقدم الذكورية بوصفها تركيبًا اجتماعيًا ضرره عظيم، بل كان يدين قطاعًا محددًا من الرجال ويصور البقية ضحايا يستحقون الدعم المعنوي، لاستعادة ما يعتبره نوعًا إيجابيًا من الذكورية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب البيولوجي للرجل.
لكن المصطلح في حد ذاته ظل بعيدًا عن الاهتمام الأكاديمي والإعلامي وحتى على مستوى الناشطية، إلى أن شق طريقه بعد عقدين إلى الدراسات والأبحاث النسوية، كتعبير شامل لوصف الحالة التي يتشكل عليها الذكور، وتدفعهم نحو التطبيع مع العنف ضد النساء، والإفراط في الاعتماد على القوة الجسدية، والرهاب من أصحاب الهويات الجندرية غير الملتزمة بالثنائية السائدة، والاستغلال المتوحش للموارد الطبيعية وغير الطبيعية لتحقيق الأمان المادي لهم.
وتعمد الأبحاث النسوية التي تناولت إشكالية «الذكورية السامة»، إلى استجلاء العلاقة المباشرة بينها وبين العنف القائم على النوع الاجتماعي وغياب المساواة الجندرية، ويدلل جميعها على أن السلوكيات العنيفة والوحشية التي يرتكبها الذكور لا علاقة لها بالسمات البيولوجية، وإنما هي نتاج للثقافة الأبوية التي نشأوا في كنفها، بالإضافة إلى تركيز الباحثات والباحثين على كشف الوجه الحقيقي للرجولة المركبة اجتماعيًا التي تبدو في ظاهرها وسيلة تمكين وارتقاء للذكور، بينما في الأصل هي أداة مُكبّلة تُقيّدهم بتوقعات وافتراضات وتضع ضغوطًا جسيمة عليهم.


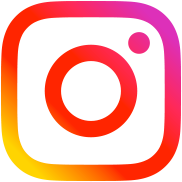





 by
by