مهجة أبو العطا تكتـــــب: إرهاب مُقنَّع

مهجة أبو العطا
عن كاتبة المقال:
حاصلة على ليسانس الاَداب والتربية في جامعة الفيوم
خريجة المدرسة النسوية التي نظمتها مؤسسة جنوبية حرة
بدأ الأمر حين تركت صديقتي تلك الليلة في محطة مترو السادات لاتّجه قاصدةً محطة المنيب التي أفضلها عادةً، ليس لشيء سوي لأنني أعرف الطريق وأحفظ مكان الموقف – تحت الكوبري – أو بالأحرى لأنني أشعر بالانتصار حين أصل إلى هناك دون سؤال القاصي والداني. أحسبني صرت خبيرة في شوارع القاهرة وضواحيها.
انطلق كالفراشة بين محطة المترو والموقف قاطعة مسافة لا تتعدى الدقيقتين، معتدة بنفسي، يتملكني شعور الزهو بالنفس لأنني أبذل جهدًا وطاقة فيما أحبه، فقد أنجزت للتو محاضرة عن القضية الفلسطينية فتحت أمامي اَفاقًا جديدة للرؤية. قد أكون مبالغةً في وصفي لمشاعري في مثل تلك الأوقات، إلا أنني أذكر أن هذا الإحساس لا يزورني كثيرًا، فلماذا لا اغتنم الفرصة واستمتع بكل تلك المشاعر من اعتداد وثقة بنفسي أو بالأحرى بــ«مهجة»!
كعادتي في أوقات السفر أفضل المقعد الأمامي بجوار الشباك، وبينما أخطو في لهفة لأجده فارغًا يقاطعني السائق سائلًا “فيوم يا أبله؟”
– أيوه.. حد قاعد هنا؟
= هتاخدي الكرسيين يعني؟
– لأ
=خليكِ ورا طيب يا أبله عشان محدش يضايقك يعني
كانت الإنفلونزا أقوى مني حينها ولم أقو على الجدال، فتركته في صمت لأجلس في أقرب مكان خال بجوار الشباك، فوجدتها بعيون تائهة، مرعوبة تجلس بجوار الشباك، وفي الخارج تقف معها صديقتها في محاولة لتهدئتها.
لم أبادر بالحديث معها بل فعلت هي، حينما أسرعت إليّ في لهفة ظنًا منها أنني سانتقل إلى عربة أخرى بحثًا عن الشباك الخالي
– تعالي أنتِ عايزة تقعدي جنب الشباك؟
=أيوه
– تعالي والنبي بس نمشي
لم أجد ما يمكن قوله سوى “شكرًا” فقد كان يومي شاقًا بما يكفي، إضافة إلى الإنفلونزا التي التهمت ما تبقى لدي من طاقة وجعلتني خائرة القوى إلى أبعد حد. لا انتظر سوى أن أميل برأسي علي زجاج الشباك وأترك الهواء ينعشني من جديد ويجبرني على الابتسامة كالعادة؛ ليقطع كل هذه الأفكار تلك الشابة نحيلة الجسد، ذات البالطو الأسود والبنطال الجينز، والوجه الدائري.
– والنبي خلي بالك منها عشان ممكن يُغمي عليها في الطريق.
=حاضر متقلقيش
لالتفت فأجدها بجواري تحث الركاب على الإسراع وتنظم المقاعد، بدلًا من السائق نفسه حتى ينطلق بأقصي سرعة.
لم أجد ما أقوله -بعد أن استشعرت تلك اللهفة والتوجس غير المبررين بالنسبة لي حتي الاَن، غير “إهدي طيب، خير إن شاء الله”، لتجيب “أهدى إزاي بس؟ بابا قالي نص ساعة وأبقى في البيت.”
أجبتها مستنكرةً بامتعاض “نص ساعة ازاي الطريق لوحده ساعتين؟!”
“ما هو مايعرفش إني في القاهرة، أنا جيت أعزي واحدة صحبتي من وراه، واتصل هزقني وقالي لما أشوف وشك بس، ونص ساعة وتبقي قدامي.”
ازداد امتعاضي أكثر وأكثر، فملابسها محتشمة سوداء كعادتنا في مناسبات العزاء، إلا أنني لم أجد سوى بضع كلمات قليلة لطمأنتها وتهدئتها، “طب اهدي بس وربنا يسهلها.”
أيقظني توترها وقلقها من حالة الإجهاد التي كانت تتملكني رغمًا عني، ثم انطلق السائق، فوجدتها على استحياء تسألني “أنا ممكن أنام على كتفك صح؟”
– أكيد طبعًا
مالت على كتفي لترافقه كوسادة يحتضنها عازب بعدما ذاق مرارة الفقد، أو كالطفل الذي ذاق مرارة التيه وتوًا وجد حضن أمه الدافئ.
مالت على كتفي وتشبثت به كما يتشبث الغريق بقشة كما نقول دومًا، ولم تترك كتفي طوال ساعتين كاملتين، مدة الطريق من المنيب للفيوم.
منذ فترة من الزمن وأنا يتملكني شعور الوحدة القاتل، الذي لم اتخذ حياله أي ردة فعل، فقد اعتدت عليه وحاولت التأقلم دون أية مقاومة، فكانت مشاعرها ولهفتها للبحث عن أي مصدر اطمئنان أواستئناس دخيلة عليّ. لم أفهمها في بادئ الأمر أو بالأحرى لم أكن أعلم أني ما زلتُ أشعر بها، إذ يبدو أنني خدرتها منذ زمن، وجاءت هي بغير قصد وأيقظتها من جديد.
كنت استنكر تعلقها بي كما يتعلق الطفل بأمه وبحثها عن أي مصدر للدفئ والأمان، فوجدت نفسي لا إراديًا احتضنها وأمسك بيدها، لأجدها تتعلق بي أكثر وأكثر وكأنما كانت تنتظر إشارة مني لأتركها تفعل. تشبثت بقوة مضاعفة تلك المرة حتى تصببت يدي عرقًا ولم تتحرر من قبضتها هي وكتفي إلا بعد مرور ساعتين كاملتين.
لم اختبر طوال عمري تجربة أن أقدم الاحتواء والدعم لأي شخص لا أعرفه، فقط أصدقائي وعددهم أقل من أصابع يدي الخمسة الذين أعرفهم جيدًا وأعرف كيف أتعامل معهم، كيف اطمئنهم، ولكن هي! أنا حتى لم أعرف اسمها، أنا بالكاد استطيع التعرف إلى ملامح وجهها، ماذا أفعل؟
في محاولات بائسة مني لجعلها تنسى أن تسألني عن الساعة كل دقيقة تقريبًا، سألتها “احكيلي طيب عندك كام سنة ومنين بقى؟”
– اطسا.. 22
= إيه ده أدي يعني، طيب أنا شايفة في إيدك دبلة، كده متجوزة ولا مخطوبة؟ معلش أنا مش بعرف أفرق بينهم
– لا متجوزة بس بينا مشاكل وعايشة عند أهلي والمفروض إني دلوقتي عند المحامي.
أعلم جيدًا ما الذي قد يجول بخاطر أي شخص قد يسمع تلك الكلمات “بينا مشاكل وعايشة مع أهلي”، قطعًا تعاني من سوء المعاملة والتهميش والنبذ، فهذه قوانين القرية عندما تعود الفتاة إلى منزل أهلها بعد الزواج.
لم أرد أن أكون سيئة الظن وتخليت عن هذه الفكرة التي اقتحمت عقلي فور سماعي كلماتها، لتقاطع هي أفكاري مؤكدةً ما كان يجول بخاطري.
“إخواتي كلهم أصغر مني ومتجوزين، وبابا دايما بيقول عني إني غلط في كل حاجة وكل تصرفاتي غلط، وما بيوافقش علي أي حاجة عايزة أعملها مهما كانت عادية.”
كان الضيق قد بدأ يتسرب إلي فور سماعي كل هذا أو ما أصفه أنا دائما بالعك، وأنا أحاول ضبط نفسي لأقصى حد حتى لا يخرج مني أي تعليق يثير ثورتها وحنقها أكثر مما هي فيه، وحين ظننت أنها بدأت تهدأ، وجدتها تنتفض بقوة “بسرعة والنبي ياسطا الله يخليك”
– يا أبله هطير يعني!
لتسألني مستنكرة “ما العربيات كلها معدية من جنبنا عادي أهي وماشية بسرعة فيه ايه بس؟”
وفي محاولات كاذبة جدًا مني، إلا أنني لم أكن أملك غيرها “عشان دي بس عربيات حديثة إنما دي طراز قديم ما تستحملش سرعة أكتر من كده.”
على ما يبدو كانت طيبة بما يكفي لتقتنع بكلماتي التي لا تقنع طفلًا في المرحلة الابتدائية، ولكنها عادت لتخبرني “والله العظيم أنا معملتش حاجة وحشة، والله كنت بعزي صاحبتي وهو ما وافقش وأمي عارفة وهي اللي قالتلي خلاص روحي، وأنا عارفة إني هتضرب، أنا عارفة بس أنا مش مهم، أنا خايفة على ماما عشان هيضربها وهي ما تستحملش، أنا خلاص اتعودت وهستحمل عادي إنما ماما هتتعب ومش قده والله.”
اعتصر قلبي اَلمًا مع كل كلمة نطقتها، وبين صوت القراَن في مقدمة الميكروباص مع تداخل أصوات المهرجانات من الركاب في الخلف، وأصابعها التي لم تكن تحتضن كتفي وإنما كادت تخترقه وأنا أتألم حقًا من تلك الأصابع المغروزة في كتفي ولكن لسبب ما أجهله لم أقو على النطق والتعبير عن ألمي أو حتى أن أنبهها لتلك الوخزات التي أنهكتني. لم تكن أصابعها فقط، كلماتها أيضًا التي كانت تخترق جسدي كله؛ ليقاطع كل هذا ضوء هاتفي بصورتي ووالدي التي وضعتها لتظهر حين يتصل ليطمئن كعادته، وعلى استحياء شديد لم أعلم سببه أجبت في إيجاز “أيوه يا بابا أنا عديت الرماية خلاص.”
عادةً أخاطب والدي “بحبيبي”، لكنني لم أستطع مخاطبته هكذا تلك المرة ولا أعلم لماذا!
هل لأنني خفت على مشاعرها أم لأنني لم أكن أملك أي إجابة لسؤالها الدائم، الذي كنت أتعمد التهرب منه وسط كلماتها “هو ليه بيعمل معايا كده؟!”، لتقاطعني قائلة وأنا أغلق الخط”أهو باباكِ أهو مقالش حاجة، وعادي الساعة 8 يعني لسه بدري، يعني أنا معملتش جريمة.”
تبادر إلى ذهني بإلحاح جملة واحدة فقط “أنتِ تعرفي أنا اتخانقت كام خناقة ولمدة كام سنة، عشان أقدر أكون في الموقف ده دلوقتي؟!”، لكن جاءت ردة فعلي مغايرة تمامًا لما خطر بذهني واَثرت الصمت لتكمل هي”هيقعدني من الشغل والله، أنا مش عايزة أي حاجة غير أطمن على أمي بس، وأوصل ويغمى عليّ مش مهم، طب بصي والنبي لو أغمي علي، طلعي الموبايل من الشنطة وقوليلهم إنك لقيتيني واقعة في الشارع.”
– مش هيغمى عليكِ ولا أي حاجة وكله هيبقي تمام والله
= تمام إيه بس! أنا نفسي أوصل وأموت حتى، والله ما فارق معايا، أوصل بس واللي يحصل يحصل. طب هو هيحصل إيه؟!
لم أكن أملك إجابة ولا أعلم ما الذي ينبغي علي قوله، فقد كان تشبثها بيدي وكتفي يزداد ويزداد وألمي يزداد ولم أقو على التعبير عنه.
– طب أنا هركب تاكسي أول ما هاوصل إن شاء الله وأكيد هيوصل بسرعة صح؟
= أها التاكسي هيمشي بسرعة مش هياخد وقت
– طب أنتِ مش هتسيبيني؟!
= يا ستي والله ما هسيبك أنا معاكِ أهو ولحد ما أركبك كمان والله ما هاروح في حته.
وصلنا أخيرًا إلى المسلة -مدخل الفيوم- وحتى هناك أبت أن تترك يدي، ولم تتركها إلا أمام التاكسي الذي حرصت أنا على اختياره بعناية.
– اطسا ياسطا؟
= اؤمري با أبله فين هناك؟
تركتها لتصف المكان الذي لا أعرفه حتى، وأنا أحثها على الإسراع وأوصي السائق الذي لم يكن لدي أي خيار اَخر غير الوثوق به،”الله يكرمك ياسطا بسرعة وفي المكان اللي تقولك عليه”، ودعتني بأعين مرتجفة لن أنساها ما حييت، لم تنطق سوى “شكرًا”.
ودعتها وأنا لا أعرف سوى اسمها ومركزها وكل ما حكته من تعنيف ورعب وإرهاب، ودعتها وأنا مُحمّلة بقدر من الثقل والضيق لم أحمله يومًا في حياتي، ودعتها وأنا لا أعلم ما الذي ينبغي علي فعله في موقف كهذا، ودعتها وأصابعها تركت ما تركت من أثر في يدي كلما تحسستها، ولم تودعني هي الأخري حتى الآن، ودعتها وكل سؤال سألته إجابته بديهية لأي إنسان سوي من حقه أن يحيا حياة كريمة. لم تودع عقلي، ودعتها وأنا أسب وألعن منابع الإرهاب تلك المتجسدة في صورة اَباء، ودعتها وأنا منكسة الرأس، متذكرة كل هزيمة سابقة مررت بها في حياتي، فقط لأنني بنت.
مرت ثلاث ليال على تلك التجربة البشعة، التي أحسبها أسوأ ما خضت من تجارب، بعد ما يعتريني من شعور بانسحاق اَدميتي في أتوبيسات النقل العام في القاهرة. أي فعل في الدنيا -وإن كان خطأ- لا يستحق كل هذا القدر من الإرهاب والتعنيف. تلك الحالات التي نجدها ونسمع عنها صدفةً والذي لا نعرفه ولا نسمع عنه من إرهاب وتعنيف داخل كل أسرة، هو إرهاب مُقنّع بخوف الاَباء الزائد ووصايتهم الزائفة.
إلي تلك الغريبة التي رأيت صدقها من أصابعها المغروزة في كتفي حتى الآن، أتمنى أن تكوني بخير.
*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبته/كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي «ولها وجوه أخرى»


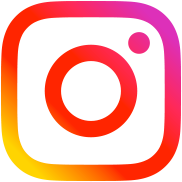





 by
by