قراءة في كتاب «لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟» – (2): محاولة استعادة حق «ملك حفني ناصف» المهدور
استكمالًا لقراءتنا في كتاب «لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟»، للكاتب والناقد شعبان يوسف، الذي يتناول في عشرة فصول، مسيرة عدد من أبرز الكاتبات العربيات في القرن العشرين، ومعاناتهن من التهميش، والتمييز، والتشويه أيضًا.
في الحلقة الثانية، نتناول الفصل الذي خصصه الكاتب لإحدى رائدات الحركة النسوية، وهي ملك حفني ناصف، وقد اختار له عنوان «ملك حفني ناصف: شروق مبكر وغروب فاجع، وضحية لخديعة ذكورية».
الاستبداد يطرق باب «النساء» أولًا
في مقدمة هذا الفصل، يرد الكاتب على الانتقادات، التي قد يوجهها البعض إلى فكرة الكتاب وعنوانه تحديدًا، ومبعثها القول بأن الكُتّاب الرجال أيضًا بينهم من يموت حسرة وكمدًا، وهو ما لم ينفه يوسف، لكنه في الوقت نفسه، يؤكد أن المشكلة لا يمكن اختزالها في رجل وامرأة، لأنها تتركز في ثقافة اجتماعية سائدة، أخضعت النساء لكم لا حصر له من القوانين والشرائع واللوائح الممانعة والقامعة.
ويمضي يوسف ليؤكد أن الثقافة الشعبية التي تقهر المرأة، تكونت وترعرت في ظل نظم سياسية واجتماعية تقوم على فكرة الاستبداد عمومًا، وتصبح المرأة هي أول باب تطرقه تلك النظم لقهرها، ويربط يوسف بين هذه الفكرة والمقولة التي اعتادت الألسنة ترديدها «إذا وجدت جريمة ما، فابحث عن المرأة».
ولدت المقاومة من رحم الخذلان

ملك حفني ناصف
يتناول الكاتب في هذا الفصل، مسيرة ملك حفني ناصف، إحدى رائدات الحركة النسوية، وقد حاول بلغة مناصرة أن يعيد إليها حقها المهدور، الذي بخسته حتى بعض القراءات التاريخية للحركة النسوية في مصر، التي اعتبرت أن ميلادها كان على يد هدى شعراوي ورفيقاتها، ممن حالفهن الحظ وعاصرن ثورة 1919، وهو الحدث الذي ساهم في نضوج الحركة النسوية، ومنحها طابعًا ثوريًا على عكس الإصلاحي الذي هيمن عليها قبل الثورة، لكنه لم يخلقها.
يتحدث الكاتب عن ميلادها (1886) ونشأتها، التي وفرت لها قدرًا كبيرًا من الثقافة والمعرفة والذوق الفني، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى أبيها الذي كان شاعرًا وناثرًا، الذي حرص على تعليمها وتثقيفها، وهو ما لم يكن معتادًا ومألوفًا وقتذاك، فنالت الشهادة الابتدائية في العام 1900، وتسلمتها في العام 1905، ونظمت الشعر وهي في الحادية عشرة.
ويورد الكاتب رواية الكاتبة والناقدة سهير القلماوي، عن زواج ناصف، الذي حدث في العام 1907، وبحسب روايتها، فإن صديقًا لوالدها جاء يقدم له عريسًا، يدعى عبد الستار الباسل، رئيس قبيلة الرماح في مدينة الفيوم، وكان رجلًا متعلمًا ويجيد اللغات الأجنبية، ومن أكبر الأثرياء، مما عزز قبول والدها به زوجًا لابنته، وبحسب ما ذكره شقيقها مجد، في كتابه «تحرير المرأة في الإسلام»، الذي صدرت نسخته الوحيدة في العام 1924، فإن والدها كان يعتقد في إعطاء الفتاة حريتها التامة في الموافقة على اختيار الزوج، أي أن الفتاة وافقت على الزواج ولم يرغمها أب أو أخ.
الصدمة والخذلان واجهتهما ملك حفني ناصف، بعد زواجها بذلك الرجل، الذي تبين كذبه وزيف جل إدعاءاته عن نفسه بعد زواجهما، فقد اكتشفت أنه أخفى عنها وعن أسرتها زواجه الأول، ووجدت نفسها زوجة ثانية، مطالبة بتعليم ابنة له، رغم أنه زعم قبل الزواج أنه ما أنجب بناتًا قط.
ويشير الكاتب إلى أن ناصف، لجأت حينها إلى المقاومة عبر الكتابة والدفاع عن حقوق النساء، والمطالبة بتعليمهن وتثقيفهن، وربما دافعها في ذلك، هو حلمها بأن تنقذ الأخريات من الفخ الذي وقعت فيه دون أن تعترف به.
يستشهد الكاتب شعبان يوسف، بأجزاء عدة من مقالات لناصف، لا سيما التي نشرتها في كتابها «النسائيات»، ليؤكد على ريادتها في مناقشة القضايا الملحة في ذلك العصر، وليكشف أنها لم تهب الاشتباك مع الرجال من أعلام ذلك الوقت، وينقل من خلال مقال لها، كيف كانت تؤمن أن المرأة لو توفر لها ما للرجل من فرص، لكانت سبقته في كل المجالات، العلم والأدب والثقافة، «نحن نعترف لرجال الاختراع والاكتشاف بعظيم أعمالهم، ولكني لو كنت ركبت المركب مع خريستوف كلومبس، لما تعذر علي أنا أيضًا اكتشاف أمريكا.»
لا تبخسوا ملك نضالها
يتجنب الكاتب الخوض في رأي ورؤية ناصف للحجاب – التي كانت داعمة له – ويقول «وأنا هنا لا أريد أن أشرح ما قالته ملك في ذلك الشأن أو غيره، ولكنني مشغول بأن ملك حفني ناصف، كانت هي السيدة الرائدة التي طرحت عدة موضوعات على بساط البحث والمقاومة، مناقشةً في ذلك أكبر أعلام ذلك العصر، رغم صغر سنها في ذلك الوقت، ولاغم أنها امرأة تقاوم ترسانة من الأعراف والتقاليد واللوائح.»
الأهم في ذلك الفصل، هو الرد على من بخس حق ملك حفني ناصف، وقد أشار الكاتب في هذا الصدد إلى المفكر المصري سلامة موسى، الذي زعم بأنها لم تترك أثرًا في الحركة النسوية ولم تستطع أن تُنشئ تيارًا مقاومًا، للخزعبلات الكثيرة التي كانت تحيط بالمرأة، وهنا يؤكد الكاتب أن الحوارات التي أدارتها ناصف في زمانها كانت في متن عملية تطور الوعي النسائي، وتركت أفكارًا ومبادئ بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معها، وذلك على الرغم من رحيلها المبكر، في الثانية والثلاثين من عمرها، إثر إصابتها بالحمى الإسبانيولية.
أبعد من ذلك، يرى الكاتب أن ناصف كانت من أطلق الشرارة الأولى والأكثر سطوعًا في المطالبة بحريات النساء ربما أكثر من قاسم أمين، لأن الأخير من وجهة نظر الكاتب، كانت أطروحاته متقدمة إلى حد كبير عن عامة الناس، ولم يكن عصره قادرًا على استيعاب مادته، واصفًا إياها بالرائدة الحقيقة للحركة النسوية وليست هدى شعراوي التي حملت اللقب على مدار عقود.
وعلاوة على ما قاله الكاتب، يمكننا النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فربما لم يخش قاسم أمين، الإفصاح عن اَرائه التقدمية، والتبشير بها، استنادًا لامتياز حظي به كرجل في مجتمع ذكوري حتى النخاع، وهو ما لم تملكه الأنثى ملك، التي إن كان القول بأن ما نادت به كان أكثر تحفظًا من أمين صحيحًا، فإن ذلك لم يحمها من الانتقاد اللاذع والهجوم، أما بشأن ما قاله سلامة موسى، عن أنها لم تترك أثرًا في الحركة النسوية، فربما يكفي الإشارة إلى اعتراف هدى شعراوي نفسها بريادة ناصف عندما كتبت عنها في مذكراتها تقول «فقد حدث في صبيحة يوم ٢١ أكتوبر ١٩١٨ أن جاءتني إحدى المربيات في ثياب سوداء، تعودت أن تزورني بها مجاملة لي في حزني على شقيقي وقد بادرتني بصوت متهدج قائلة: لقد ماتت الباحثة! وشعرت بهزة حزن في نفسي لهذا الخبر .. وما كنت أظن أن شيئًا في الحياة بعد فقدان أخي يستطيع أن يهز شعوري هذه الهزة العنيفة، وقد عجبت لذلك إذ كنت قد قطعت كل صلة بالحياة، وحسبت أنه لم يبق في شعوري متسع لغير حزني على أخي، وكدت أثور على نفسي وعلى تلك التي أحدثت هذا التأثير فيها، ما الذي يعنيني أنا أن الباحثة قد قضت؟ وأن البلاد نساءها ورجالها، قد خسروا في نهضتهم عضوًا هامًا بوفاة تلك السيدة الفاضلة. وفي تلك اللحظة انفردت في مخيلتي صفحة بيضاء ذات إطار أسود لهذه السيدة، وخيل إليَّ أنني أسمع صوت باحثة البادية وهو يدوي في قاعة المؤتمر الذي عقد عام 1910 مطالبًا بحقوق عشرة للنساء.»
وفيما يخص وصف الكاتب لها برائدة الحركة النسوية، فالأزمة سواء ذُكِرَت ناصف أو شعراوي، التي تنسب ريادة حركة النضال الطويل لامرأة واحدة دون غيرها، بغض النظر عن إسهامات أخريات في ذلك الوقت، خاصة أن ملك حفني ناصف لم تكن وحدها من خاض في قضية تحرير المرأة من القيود، قولًا وكتابةً، ولا يمكن إغفال دور نازلي فاضل أو زينب فواز وغيرهما، ممن خرجن عن الإطار التقليدي ونادين بما يخالف السائد اَنئذٍ، حتى إن كانت دعواتهن محافظة بالنظر إلى ما أثاره جيل ما بعد ثورة 1919.
وسكن الجسد مبكرًا
في ختام هذا الفصل، يربط الكاتب بين الخاص والعام، وكيف تحملت ناصف ما لم تتحمله امرأة في زمانها على حد قوله، فقد حافظت على ألا يعلم أحد بفشل زواجها، وتحملت مشقة وعناء هذا الزواج وحدها، فمرضت. أما النهاية فقد جاءت عندما ألقي القبض على شقيقها مجد بتهمة تهريب ضابط سجين، يجاهد في سبيل مصر، وهو ما لم تتحمله، وسارعت بالعودة من البادية في الفيوم إلى القاهرة، على الرغم من أنها محمومة، ولم يشغلها سوى الاطمئنان عليه، وأسرها بالفعل رؤيته، لكن المرض اشتد بسبب الرحلة والإجهاد والتوتر، وكان صوته الأعلى، فأخمد المقاومة، وأسلمت له تلك الروح الذكية، لكن الكاتب لم يختزل النهاية في هذا المشهد، وبنظرة أوسع وأشمل للمعاناة يرى «كانت حياتها سلسلة من المتاعب والاَلام التي أودت بها، ولكن يظل صوتها عاليًا أبدًا في ساحات الحريات والعدالة الاجتماعية عمومًا، كواحدة من الرائدات الأوائل في القضية المرفوعة منذ قرون، ألا وهي قضية حريات المرأة.»


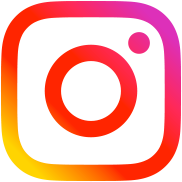





 by
by