بعد أكثر من عقد على إعلانها العنف ضد النساء أولوية: المنظمات الدولية تطمر رأسها في الرمال
إعداد آلاء حسن وشهد مصطفى
«يجب إعطاء العنف ضد النساء أولوية أكبر على جميع المستويات، لأنه لم يحظ حتى الآن بالأولوية المطلوبة لتحقيق تغيير ملموس.»
الأمانة العامة للأمم المتحدة
أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة في العام 2006 أول دراسة دولية معمقة بشأن العنف ضد النساء، في إطار مسعاها لاستنهاض الحكومات حتى تتخذ مزيدًا من التدابير لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد أجريت هذه الدراسة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 58/185، الذي وجه فيه الأمين العام بإجراء دراسة موسعة للوقوف على الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء وعواقبه متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى تقدير الكلفة الصحية والاقتصادية له، على أن تشمل الدراسة استعراضًا لأكثر الممارسات والتدخلات فاعليةً للحد والوقاية من جرائم العنف ضد النساء، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية.
بعد إصدار الدراسة بأربع سنوات دشنت الأمم المتحدة منظمتها للمرأة (UN Women)، وأعلنت حينذاك أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع وتكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة الجندرية، وتمكين النساء، والقضاء على العنف ضدهن. وقد أصدرت منظمة أوكسفام الدولية تقريرًا قبل انطلاق أعمال الأمم المتحدة للمرأة رسميًا في فبراير من العام 2011، تبرز من خلاله أصوات ناشطات ومدافعات عن حقوق النساء من مختلف أنحاء العالم، يطالبن المنظمة الأممية الجديدة بأن تضع قضية العنف ضد النساء على رأس أولوياتها، وهو ما تعهد به فعلًا الكيان الوليد آنئذٍ.
وفي العام 2013، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) لأول مرة، أن العنف ضد النساء قد أضحى مشكلةً صحية عالمية ذات أبعاد وبائية، وذلك بالتزامن مع إصدارها دراسة منهجية للبيانات العالمية المتعلقة بانتشار العنف ضد المرأة، تضمنت مبادئ توجيهية للدول من أجل تحسين قدرة القطاعات الصحية على التصدي لهذه الأزمة. ثم تبنت الأمم المتحدة بعد ذلك بعامين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبينها هدف المساواة الجندرية، الذي وضعت الهيئة على رأس مقاصده «القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص.»
كل هذه التحركات التي بدأت قبل 17 عامًا، من المفترض أن تدرك النساء آثارها في الوقت الحالي، إلا أن هذا لم يحدث وتحديدًا على مستوى الإحصاءات المتعلقة بجرائم العنف التي تستهدفهن، رغم تحقق تغيير لا مراء فيه على صعيد التشريعات الوطنية على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية، إذ تتابع إقرار الدول لقوانين تجرم العنف المنزلي حتى بلغ عددها 158 دولة أي ما يتجاوز ثلثي دول العالم، ووصل عدد الدول التي أصدرت قوانين تجرم التحرش الجنسي في العمل إلى 141 دولة حتى نهاية العام 2020. ومع ذلك، أخفق السواد الأعظم من هذه التشريعات في تضييق الخناق على العنف ضد النساء، إما لهشاشته وإما لخلل في إنفاذه على الأرض.
العنف ضد النساء يُراوِح مكانه.. من يتحمل المسؤوليةَ الكبرى؟
قبل عشر سنوات أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا، يكشف أن واحدةً من كل ثلاث نساء في شتى أنحاء العالم يتعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي الذي غالبًا ما يكون مرتكبه هو الشريك الحميم، ثم عادت وأصدرت نسخةً محدثة من التقرير في العام 2021، ليتضح أن شيئًا لم يتغير فلا تزال النساء تتعرض للعنف بنفس المعدلات تقريبًا، وما برح ثلث النساء يواجهن العنف الجسدي و/أو الجنسي.
عند طرح معضلة بقاء معدلات العنف ضد النساء مرتفعة، غالبًا ما تتوجه أصابع الاتهام صوب الحكومات التي تتقاعس عن مواجهة الأزمة بحسم، لأنها تتماهى مع الثقافة المطبعة مع العنف القائم على النوع التي صنعتها ورسختها قوى اجتماعية ومؤسسات دينية ترعى الأيديولوجية الأبوية، أو لأنها تخشى الدخول في تنازعٍ مع هذه المنظومة التي تتمتع بقاعدة شعبية صلبة.
ورغم واقعية ما تتحمله الحكومات من مسؤولية ضخمة إزاء بقاء الوضع على حاله إلى حد كبير، فإن المؤسسات الدولية الكبرى التي أعُطي لبعض منها صفة الحكومة العالمية – بحكم الأمر الواقع – نظرًا للصلاحيات التي تحظى بها، تتحمل مسؤوليةً جسيمة في هذا الصدد، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
على عكس التصور الشائع، لا تنحصر مهام الأمم المتحدة في إطلاق الحملات وتخصيص الأيام الدولية لرفع الوعي وزيادة العمل القاعدي حول قضايا بعينها، أو إجراء دراسات وإطلاق تقارير استرشادية، أو عقد اجتماعات وإصدار إعلانات وقرارات غير ملزمة، بل يناط بها مراقبة التزام الدول بتنفيذ بنود المعاهدات الدولية، ومتابعة تطبيق الحكومات للقرارات الصادرة عنها، ووضع معايير دولية يجب على الدول أن تستند إليها لتطوير قوانينها، فضلًا عن العمل مباشرة مع الحكومات والمجتمع المدني على تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية والمحلية، وكل هذه الأمور كان بالإمكان أن تُحدِثَ أثرًا وصدى تستشعرهما النساء فيما يخص العنف الموجه ضدهن، إلا أن تنفيذ هذه المهام المشوب بكثير من المشكلات على مدى سنوات طويلة، وافتقار بعضها لمسألتي «الإحكام» و«الإلزام» يحول دون تحقيق التغيير المُبتغى.
مواضِع الفشل وسبل ضبط المسارات
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 23 عامًا، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (CEDAW)، التي صادق عليها حتى الآن 189 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193، وهي أول اتفاقية أممية تتناول بعمق قضية التمييز ضد النساء.
لم تتعرض نصوص الاتفاقية إلى قضية العنف ضد النساء، وإنما أصدرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW Committee) المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لبنود الاتفاقية، توصيتين بشأن هذه القضية بوصفها شكلًا من أشكال التمييز ضد النساء التي يتعين عليها مكافحتها، ومن ثم صار على الدول الأطراف أن تعدّل تشريعاتها وتطور سياساتها، وأن تفرد جزءًا في تقاريرها الدورية لتوضيح الجهود المبذولة لمواجهة العنف ضد النساء. وتحمل التوصيتان رقم (19) ورقم (35)، وقد اعتمدت اللجنة التوصية الأولى في العام 1992، ثم الثانية في العام 2017.
لم تفلح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وتوصيات لجنتها في تحقيق الحماية للنساء من العنف القائم على النوع، ليس فقط بسبب عيوب في النصوص وإنما أيضًا لأنها تقف عند حد مطالبة الدول بالالتزام بما جاء فيها، ولا يمكنها إلزام الدول بالتنفيذ، ولا يحق لها اتخاذ إجراءات ضد الحكومات حال امتناعها أو تقصيرها في التنفيذ.

ورغم أن حقيقة الإخفاق جليةً منذ سنوات عديدة، لم تطرح الأمانة العامة للأمم المتحدة ولا أي من الدول الأطراف في الاتفاقية مسألة إخضاعها للتعديل وفقًا للمادة رقم (26)، التي تجيز لأي دولة صادقت عليها أن توجه إشعارًا كتابيًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تطلب فيه إعادة النظر في الاتفاقية لتعديل مواد أو أجزاء منها.
تعامي الأمم المتحدة ومنظماتها والحكومات كذلك عن الحاجة الملحة لمعالجة الإخفاق والتوقف عن التحايل على الواقع، أثار ولا يزال غضب كثير من الناشطات حول العالم، وهو الأمر الذي دفع ما يزيد عن 1700 منهن في نحو 128 دولة، إلى البحث والاستقصاء والتشاور مع خبيرات وخبراء في قضية العنف القائم على النوع، ومحاميات ومحامين، وطبيبات وأطباء، لصياغة اتفاقية دولية تختص بقضية العنف ضد النساء والفتيات، بهدف سد الثغرات ورتق الفجوات الحاضرة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
صدرت المسودة الأولى للاتفاقية في نوفمبر من العام 2021، تحت عنوان «معاهدة كل امرأة» أو «Every Woman Treaty»، بدعم من بعض الشخصيات الدولية مثل: القاضية الإيرانية شيرين عبادي والناشطة الحقوقية الأمريكية جودي ويليامز، الحاصلتان على جائزة نوبل للسلام، ورئيس نيجيريا في ذلك الوقت محمد بخاري، ووزير خارجية الأوروغواي السابق لويس ألماغرو.
لكن يظل مصير مشروع الاتفاقية مشروطًا بتبني مجموعة من الحكومات لها حتى يصبح بالإمكان طرحها للنقاش الرسمي، أو تبني هيئات دولية لها كالأمم المتحدة أو إداراتها أو منظماتها.
هناك إشكالية أخرى تقود إلى الإخفاق، فعلى الرغم من التزام الأمم المتحدة بنشر دلائل إرشادية للدول الأعضاء تركز على صناعة القوانين وتطوير نظام العدالة، لا سيما فيما يتعلق بالعنف ضد النساء، كـ«دليل التشريع حول العنف ضد المرأة» الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ تظل آليات رصد ومراقبة تطبيق المبادئ الواردة في هذه الإصدارات ضعيفةً ومهلهلةً، ولذلك يقترح بعض مقرري الأمم المتحدة نظام مراقبة لا يعتمد فقط على لجان الخبيرات والخبراء المستقلين، وإنما يضع هيكلًا دقيقًا ومفصلًا لتقارير يعدها مراقبات ومراقبون، من خلال طرح أسئلة مباشرة تتطلب إجابات محددة، ولا تقتصر على العامة منها بل تشمل أسئلةً معمقة، فإذا كان أحد محاور التقرير يتناول الالتزام بتعديل وتطوير التشريعات الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، فقد تتطرق الأسئلة إلى أمور كتأهيل القطاع الشرطي للتدخل والتعامل مع العنف المنزلي استنادًا إلى هذه المعايير، أو الالتزام بإدراج الاغتصابات الشرجية والفموية والاغتصاب بالآلات الحادة ضمن تعريفات قوانين مكافحة العنف ضد النساء لجريمة الاغتصاب، بما يجعل التقارير كاشفة لمواطن الضعف والقصور التي تستحق مزيدًا من التركيز، وضغطًا مضاعفًا على الدول من أجل معالجتها.
علاوة على ذلك، تحتاح الأمم المتحدة ومنظماتها إلى أن تكون أكثر قربًا وتواصلًا واستيعابًا للمجموعات والمنظمات النسوية الفاعلة والنشطة، إذ يبدو أن قطاعًا من الناشطات والمدافعات اللاتي غمرهن الأمل عقب تدشين منظمة الأمم المتحدة للمرأة، من جراء ما أحاطها من شعارات براقة ووعود مزهرة، يشعرن حاليًا بالإحباط تجاه هذا الكيان لاقتناعهن بأنه يصب جل تركيزه على التنسيق والتأثير على الحكومات وكتابة تقارير «لا نهاية لها»، على حساب دعم المنظمات النسوية القاعدية والتعاون معها.


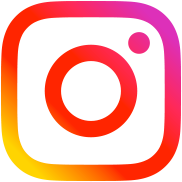





 by
by