حوار – المخرجة أسمـاء جمال: النســاء صاحبات فضل كبير على صناعة السينما المصريـة
عايش العاملات والعاملين بصناعة السينما في شتى أنحاء العالم، معاناة استثنائية خلال العام 2020، بسبب جائحة كورونا (COVID-19) وما فرضته من خسائر على هذا القطاع، ومن تعطيل للكثير من المشاريع السينمائية سواء كانت مستقلة أو تجارية، إلا أن الشهور الأخيرة من هذا العام شهدت محاولات من جانب بعض المهرجانات السينمائية الدولية والإقليمية والمحلية، لاستحداث أدوات وآليات تُمكّنها من الانعقاد، لدعم صنّاع الأفلام والمشاريع السينمائية فنيًا وماديًا، وإبقاء محبي السينما متصلين بالشاشة الذهبية، وهو ما أنعش الأمل، وبعث النشـاط، وجدد الطاقة في نفوس العديد من الصنّاع لا سيما الشابات والشباب المستقلين، بعد شهور ملأتها عثـرات عُضال وخيبات هائلة.
المخرجة الشابة أسماء جمال كانت واحدة من هؤلاء، فقد اختتمت العام بجائزتين في حوزتها، إذ فاز فيلمها الوثائقي القصير «المرسال اللي بعته» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان السينما للجميع الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان مصر دوت بكره للأفلام، فضلًا عن الاحتفاء الخاص الذي حظي به خلال فعاليات برنامج «أيـام سيما دكة للفيلم القصيـر»، وهو برنامج غير تنافسي لصناع الأفلام القصيرة العرب، وتنظمه مؤسسة «دكة أضف» بمقرها في القاهرة.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت أسماء بفيلمها في مهرجان MANWTFFF الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ومهرجان سيليكون فالي للفيلم الأفريقي «The Silicon Valley African Film Festival» الذي يقام في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
أسماء جمال مخرجة ومصوّرة صحافية، سبق أن قدمت عددًا من الأفلام المستقلة وهي «الاستروكس» و«مهرجان مكن»، و«مصرية»، وشاركت كعضوة لجنة تحكيـم في مهرجان «Reel Youth Film Festival» الذي انطلق لأول مرة قبل عشرين عامًا في كندا.
علاوة على ذلك، شاركت أسماء جمال بالظهور في الفيلم الوثائقي «آنسة حسنة المظهر» الذي يتطرق إلى معاناة أربع فتيات (هي إحداهن)، مع الافتراضات المجتمعية المُسبقة حول المظهر الخارجي للمرأة، وتأثير ذلك على العديد من خطواتهن وأحلامهن.
بداية.. متى اكتشفت شغفك بالسينما الوثائقية تحديـدًا؟
أعتقد أن شغفي بالأفلام عمومًا مصدره حبي للكتابة ودراستي للإذاعة والتلفزيون في الجامعة، فقد حفز ذلك لدي الرؤية والمعالجة البصرية للأفكار. أما شغفي بالحكي (Storytelling)، فقد اكتشفته أثناء عملي بمجال صناعة المحتوى البصري (الفيديو) إذ صرت أتخيل ما أكتبه مرئيًا، وحينها شعرت بانجذاب شديد تجاه عالم الأفلام وصناعتها.
أنتِ تعملين أيضًا بمجال التصوير الصحافي، كيف ينعكس ذلك على ما تصنعينه من الأفلام؟
نعم، للتصوير الصحافي تأثير واضح على عملي بصناعة الأفلام، فقد اكتسبت من التصوير الصحافي خبرة عملية ضخمة في فهم الشارع وتجارب الناس المختلفة، وتعلمت مبادئ إجراء المقابلات، فضلًا عن أن العمل على إنتاج قصص صحافية متنوعة كان بمثابة فرصة ثمينة للتدريب على صناعة الفيلم الوثائقي، لأن تقارير الشارع تضعك تحت ضغط ذهني وبدني تحتاجين للتعامل معه بحرفية.
هذه التحديات ساعدتني على إنتاج أفلامي الوثائقية فيما بعد، ورغم محدودية الإمكانيات خرجت بجودة فنية أهلتها للمشاركة في مهرجانات محلية ودولية، وآخرها «المرسال اللي بعته» الذي صُنع بأيدي فريق عمل صغير للغاية، يتكون من منتج ومساعد إخراج ومخرجة، وهذا هو ما تعلمته من الصحافة، خاصة أن عملي كشخص متعدد المهام والأدوار (One Person Crew) عزز من قدرتي على تطوير الفيلم من البداية إلى النهاية، وخلال كل المراحل الفنية لصناعته.
يبدو أن لجذورك الصعيدية تأثير على اختيارك للفكرة والمعالجة الخاصة بـفيلم «المرسال اللي بعته».. أليس كذلك؟
بالتأكيد، مسألة هجرة أهلي من الصعيد إلي القاهرة، وعلاقتهم بهذه المدينة وشعورهم بالغربة فيها، وذكرياتهم مع جذورهم، كل ذلك دفعني إلى تتبع قصة علي جلال الذي انتقل في ستينيات القرن الماضي أثناء طفولته من مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر إلى القاهرة ليقيم مع عمه، وظل حريصًا على زيارة أسرته، والقيام بتلك الرحلة الطويلة من العاصمة في الشمال إلى مدينته في الجنوب بشكل دوري حتى لا تنقطع الأواصر. وقد استمر على تلك الحال حتى تزوج واستقر تمامًا في القاهرة، فأصبح تبادل شرائط الكاسيت مع عائلته هو وسيلته الأساسية للمواظبة على التواصل معهم ومشاركتهم الأفراح، والحفاظ على اتصاله بثقافة مدينته عبر الموسيقى والأغاني.
شاركت أسماء جمال بفيلمها «مصريــة» في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، ومنها مهرجان «Festival Court Derrière» في فرنسـا، ومهرجان ماكاو الدولي للفيلم القصير «Macau International Short Film Festival» في هونج كونج.
فيلمك «مصرية» ولد أثناء مشاركتك في ورشة «قافلة بين سينمائيات»، فما الذي أضافته لك هذه التجربة كصانعة أفلام؟
كانت هذه الورشة تجربة تعليمية مكثفة ومهمة جدًا، فقد أتاحت الفرصة لعدد من المخرجات المستقلات للعمل والتدريب مع خبراء من جنسيات مختلفة، وعلى رأسهم المخرجة المصرية أمل رمسيس مؤسسة «قافلة بين سينمائيات»، وقد جمعت الورشة بين الشق العملي والشق النظري، واكتسبت منها مهارات عديدة جعلتني قادرة على إنتاج فيلم من الألف إلى الياء، بدءًا من اختيار الفكرة وتطوير السيناريو، ثم التصوير، وتنفيذ المونتاج، وإتمام مختلف المراحل اللاحقة إلى أن يخرج الفيلم في نسخته النهائية.
بالإضافة إلى ذلك، لقد لعبت الورشة دورًا جوهريًا في تطويري لفيلم «المرسال اللى بعته»، وأظن أن «قافلة بين سينمائيات» حفزتني أو بالأحرى وضعتني على بداية الطريق لبدء العمل على مشروع فيلمي الروائي الطويل الأول.
«قافلة بين سينمائيات» هي مبادرة سينمائية مستقلة وعروض متنقلة ومجانية للأفلام التي صنعتها نساء، وقد أسستها المخرجة المصرية أمل رمسيس في العام 2008، وانطلقت دورتها الأولى في القاهرة، وتتنقل حاليًا المبادرة بعروضها بين العديد من الدول في المنطقة العربية، وفي أوروبا، وفي أمريكا اللاتينية.
فيلم «مصرية» بطلته هي والدتك، لماذا وقع اختيارك عليها لتكون محور العمل؟
هذا الفيلم يرتبط بشغفي بالحكي عن جذوري الصعيدية والأصول التي أنتمي إليها، وهذه هي البيئة التي نشأت فيها أمي، وشكّلت حياتنا في القاهرة، وبالطبع ظلت هذه الجذور خلفية لأحداث حياتي بطريقة لم أستطع الانفصال عنها، حتى جاءت ورشة «قافلة بين سينمائيات»، وكان على كل مخرجة من المشاركات فيها، اختيـار فكرة فيلم لتكون هي مشروع تخرجها، وعندها اقترحت المخرجة أمل رمسيس أن تجتمع ست مخرجات في عمل واحد، وأن تحكي كل واحدة منهن عن أمها في فيلم قصيـر، ليتم دمج هذه الأفلام في فيلم واحد طويل يحمل اسم «عن قرب».
لقد خرج فيلم «مصرية» من رحم هذه التجربة، مرتكزًا على معايشة غير مباشرة، إذ لا يمكن لمشاهدة أو مشاهد الفيلم أن يعرف أن مخرجة الفيلم هي ابنة هذه السيدة التي تلاحقها الكاميرا في أنحاء منزلها، وترصد مراحل مختلفة من حياتها في الحاضر والماضي، وتسجل الحالة التي تمتزج فيها الأحلام بالآلام، وما ينتج عنها من إصرار على البحث عن السعادة رغم ظروف العيش القاسية والصعبة في القاهرة.

فضلًا عن والدتك، يدور عدد من أفلامك في فلك النساء وحكاياتهن، فهل تعتقدين في وجود سينما المرأة أو السينما ذات التوجه النسوي؟
في الحقيقة لا أعرف، ولكن أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به، هو دعم احتياجنا كصناع أفلام إلى أعمال تحكي عنا بحرية ولا يُشترط أن تكون عن المرأة، لأن لدينا آلاف القصص والحكايات التي تستحق أن تُروى. أما الحديث عن ألقاب مثل «مخرجة نسوية» أو ما شابه، فأظن أن صانعة الأفلام لا تحتاج إلى تصنيف لاستكمال مسيرتها في السينما التي كان للمرأة المصرية بصمة استثنائية فيها منذ بدايتها، وطالما كان لدينا نساء مبدعات صاحبات فضل كبير على صناعة السينما سواء في الإنتاج، أو الإخراج، أو الكتابة، أو التمثيل وغيره.
وبصراحة شديدة، أعتقد أنه بدلًا من الحديث عن سينما المرأة، من الأفضل أن نقول أنه لا يمكن أن يخرج عمل فني إلى النور من دون مشاركة النسـاء. المرأة وجودها يؤثر بقوة في الفيلم، ونحن نحتاج ذلك الوجود.
تقف المخرجة والمنتجة والممثلة عزيزة أمير وراء الفيلم الروائي الطويل «ليلى» الذي صدر في العام 1927 ويعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية للسينما المصرية، لكونه أول فيلم روائي طويل في مصر والمنطقة العربية بأسرها، وبصدوره صارت عزيزة أمير أول مخرجة ومنتجة مصرية وعربية على الإطلاق، ليلحق بها عدد من الأسماء النسائية التي وضعت أسس السينما المصرية، مثل: بهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، وأمينة محمد، وآسيا داغر.
ألا تعتقدين أن التحديات التي تواجه صانعة الأفلام أكبر وأكثر تعقيدًا من تلك التي تواجه صانع الأفلام؟
أعتقد أن النساء محاربات جدًا في مجتمعنا المصري والعربي، وأوقن أنه في السينما وشتى المجالات، مسألة قيادة المرأة لفريق عمل من الرجال سواء كانت مخرجة أو مهندسة أو طبيبة أو غير ذلك تعرّضها لتحديات كبيرة، وما زالت فرق العمل في الأفلام تنظر إلى المخرجة ببعض الاستغراب بالأخص في بداية العمل، فضلًا عن الصعوبات التي تواجهها المخرجة عندما تحمل الكاميرا وتصوّر في الشارع، إذ أن ذلك غالبًا ما يعرضها إلى تعليقات سيئة وتحرش لفظي من جانب المارة. وبصراحةً، إذا كانت المرأة تعاني من التحرش الجنسي وهي تسير بشكل طبيعي في الشارع، فما بالنا إذا كانت تمسك بكاميرا وتتجول بها في الشوارع للتصوير.
شارك فيلمك «مصرية» في Festival Court Derrière، وهو مهرجان فرنسي للسينما التي يصنعها سينمائيون من الجنوب العالمي لا سيما القارة الأفريقية. إلى أي مدى يساعدك الفيلم الوثائقي على الاشتباك مع هموم وقضايا العالم الجنوبي؟
أنا سعيدة بمشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات خارج مصر، وبوصوله إلى جمهور من جنسيات مختلفة، استطاع مشاهدة حكاية أم تعيش في بيت صغير داخل حي عشوائي في القاهرة، وتفاعل مع حكايتها. هذه هي عظمة السينما ودورها كفن يهدف إلى تحقيق التقارب الإنساني. وفيما يتعلق بدوري كصانعة أفلام مستقلة، فإن الجنوب الذي انتمي إليه ولعالمه هو اهتمامي الأساسي، فأنا منشغلة بأناسه وهمومه ومشكلاته، فتلك هي الحكايات والقضايا التي عشت وأعيش فيها، ولدي شغف كبير تجاه تجسيدها على الشاشة والدفاع عن من يعيشونها عبر السينما، لإيماني بأن الأفلام أداة محورية في عملية تغيير الفكر، بفضل قدرتها الكبيرة على مخاطبة الوجدان والمشاعر.
وبشكل شخصي، أنا سعيدة لكوني فتاة صعيدية لدي مخزون من الحكايات التي يمكنني معالجتها سينمائيًا، خاصة أنني أجد أن الدراما التي تصور الصعيد المصري أقرب للأعمال الكوميدية، لأنها لا تمت للواقع بصلة على مختلف المستويات، سواء القصص، أو اللهجة، أو الديكورات، أو الملابس. كل شيء لا يعبر عن واقع الصعيد وأهله.
أهدى المهرجان الفرنسي Festival Court Derrière دورته الأخيرة التي أقيمت في أكتوبر الماضي، للمخرجة الفرنسية سارة مالدورو، التي رحلت في شهر إبريل تأثرًا بإصابتها بفيروس كورونا، وهي واحدة من أشد المحاربين ضد التمييز الذي يستهدف ذوي البشرة السوداء في الفن، وكانت واحدة من مؤسسي أول شركة إنتاج مسرحي للفنانين من ذوي البشرة السوداء في فرنسا (في العام 1956)، وتناولت في عدد من أفلامها ثورات التحرر والاستقلال في بعض الدول الأفريقية التي أحكم الاستعمار قضبته عليها طويلًا مثل أنغولا، وغينيا بيساو.
في رأيك، ما التحديات التى تواجه السينما المستقلة وصنّاعها في مصر؟
للأسف تم الترويج إلى أن الأفلام المستقلة نخبوية ومليئة بالتنظير، وهذه السمعة حرمتها من الانتشار الجماهيري الذي تستحقه، وحتى الأفلام التسجيلية التى تعرضها بعض القنوات العربية هي أقرب إلى التقارير التي تذاع في البرامج الحوارية وليست أفلامًا بالمعني الحقيقي.
أتمنى أن يجد صناع الأفلام المستقلة مساحة ليدخلوا بأفلامهم إلى البيوت المصرية، وتنتشر ثقافة مشاهدة الفيلم القصير الوثائقي والروائي، وأتمنى لو كان بوسعي أن أعرض أفلامي لعموم الناس حتى يستمتعوا بمشاهدتها من دون مقابل مادي. كنت آمل أن يُعرَض فيلم «مصرية» في مدينة أسوان التي خرجت منها حكاية الفيلم، ولكن من المُحزن أن يغيب عن محافظة سياحية كأسوان دور العرض السينمائي. هل يُعقَل أن يسافر الفيلم إلى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان، ولا يُشاهده أهل بلده؟!


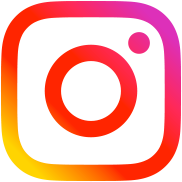





 by
by