حيواتهم تستحق.. وحيواتهن أيضًا: لماذا تظل معاناة وخسائر النساء الملوّنات في الخلفية؟
دفعت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في الولايات المتحدة، بالتمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصول أفريقية ليكون أحد القضايا الرئيسة والأساسية التي يتناولها الإعلام الدولي بكثافة ويختصها بالقراءة والتحليل أكثر من أي وقت مضى. وعلى مدار الأسابيع الماضية تدافع المحللون والباحثون لتقديم رؤاهم ومناقشة آرائهم بشأن العنصرية الممنهجة في الدولة الأكثر تأثيرًا في العالم، والتي تعود جذورها التاريخية إلى أكثر من 400 عام مضت، عندما بدأ المستعمرون الأوروبيون في استقدام مواطنين من القارة الأفريقية، عبر ما كان يُعرَف باسم «تجارة العبيد» للقيام بأعمال الإعمار في أمريكا الشمالية.
اندلعت المظاهرات المنددة بالعنف الشرطي والعنصرية الممنهجة ضد المواطنين الأمريكيين من أصول أفريقية في الـ26 من مايو الماضي، بعد ساعات من مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل أفريقي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بينما كان أحد ضباط الشرطة يضغط على عنقه بركبته لمدة تقترب من تسع دقائق، وهي الجريمة التي صورتها فتاة من أصل أفريقي تدعى دارنيلا فرايزر بالكاميرا الخاصة بهاتفها النقّال، ثم سارعت بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح القشة التي قسمت ظهر البعير، والمؤجج لموجة من الغضب العارم اجتاحت الولايات المتحدة وعدد من دول العالم.
ومثل أغلب القضايا الاجتماعية، فإن التمييز ضد الأمريكيين من أصول أفريقية يتعاطى كثيرون معه بوصفه الأزمة المديدة التي يعاني منها «الرجل» الأمريكي ذو البشرة الداكنة، فيتوجهون إليه بالخطاب، ويبحثون عن تأثيرها عليه، ويحيطونها بمفردات ذكورية، بينما تغيب عن رؤيتهم النساء ذوات الأصول الأفريقية رغم أن معاناتهن أكثر تعقيدًا.
لماذا يحتاج إدراج أسمائهن في قوائم ضحايا العنف العنصري إلى حملات ضغط؟
ينصب الحديث الدائر حول الاحتجاجات التي تشهدها حاليًا الولايات المتحدة، على «الرجال» الأمريكيين من أصول أفريقية وجرائم العنف الشرطي ضد هؤلاء الذكـور، وإن امتد ليشمل النساء، يتجه عادةً إلى زوجات الضحايا وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، ويمكن الاستدلال على ذلك بالخطاب الغالب في وسائل الإعلام الأمريكية حتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو الجاري، التي عندما أرادت أن تحيي ذكرى ضحايا وحشية الشرطة الأمريكية من ذوي البشرة السوداء خلال السنوات الأخيرة، للتأكيد على الحقيقة التي تنفيها أطراف عديدة داخل الدولة وعلى رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بوجود «تمييز ممنهج ضد ذوي البشرة السوداء»، اختار معظمها أن يستعيد قصة فريدي غراي الذي قتل في إبريل من العام 2015، ومايكل براون الذي قتل في أغسطس من العام 2014، وتامير رايس الذي لقي حتفه في نوفمبر من العام 2014، بالإضافة إلى أحمد أربري الذي قتل في فبراير الماضي ليس بأيدي أو رصاص شرطيين، وإنما برصاص رجلين من ذوي البشرة البيضاء، لحقا به أثناء ممارسته رياضة الجري وقتلاه ظنًا منهما أنه يركض هربًا بعد ارتكابه لجريمة ما. في المقابل، لم يأت ذكر اسم بريونا تايلور بين الأسماء التي سلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء عليها وعلى قصصها إلا فيما ندر.
وكانت بريونا تايلور قد قتلت برصاص رجال الشرطة في الـ13 من مارس الماضي، بعد اقتحام منزلها ليلًا لتنفيذ أمر تفتيش من دون إنذار مسبق، ولم يصبح اسمها أساسيًا في القوائم التي صنعها الإعلام إلا بعد أن شرعت ناشطات في التدوين والتغريد عنها مستخدمات وسم #اذكروا_اسمها (#SayHerName)، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر من العام 2014، عندما دشنه منتدى السياسة الأفريقية الأمريكية ومركز الدراسات التقاطعية والاجتماعية، الذين أسستهما كيمبرلي كرينشو الأكاديمية الأمريكية من أصول أفريقية وواضعة نظرية «التقاطعية» التي سنتناولها بقدر من التفصيل في هذا المنشور.
وقد أطلقت الجهتان هذا الوسم قبل ما يقرب من ست سنوات، في إطار حملة بالاسم نفسه تسعى إلى توثيق ونشر قصص النساء ذوات البشرة السوداء اللاتي يقضين تأثرًا بالعنف الشرطي العنصري، ولا يحظين باهتمام سياسي وشعبي، ولا تلقى جرائم قتلهن تغطية إعلامية مثل تلك التي تلقاها جرائم قتل الرجال من ذوي الأصول الأفريقية على أساس عنصري.
نالت جريمة قتل بريونا تغطية إعلامية خجلة بعد وقوعها، وصاحبها تفاعل محدود من جانب النشطاء المدافعين عن حقوق البشرة الملوّنة، ولم تستقطب اهتمام السياسين إلا مؤخرًا، ولذلك لا يزال قتلتها أحرارًا ولم تُوّجه إليهم أي تهم حتى الآن، على عكس قتلة جورج فلويد الراحل بعدها بشهرين، وقتلة أحمد أربري الراحل قبلها بشهر، وهو ما توقفت أمامه كمالا هاريس، السيناتورة بمجلس الشيوخ الأمريكي وصاحبة الأصول الأفريقية، التي غردت عبر حسابها على موقع تويتر بتاريخ الرابع من يونيو الجاري، منتقدةً تجاهل جرائم قتل الأمريكيات من ذوات البشرة السوداء ومن بينهن بريونا تايلور، وجاء في تغريدتها «الضباط الذين قتلوا بريونا تايلور منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر لا يواجهون اتهامات. لا يمكننا أن ننسى النساء ذوات البشرة السوداء في مسعانا إلى العدالة.»
ولكن مع زيادة الضغط بدأ الموقف يتغير، إذ ساهمت الحملة التي انطلقت بالتزامن مع عيد ميلادها الـ27 الذي حل في الـخامس من يونيو الجاري، تحت اسم «عيد ميلاد لبريونا»، في إعادة قضيتها إلى الواجهة وللنقاش الإعلامي والسياسي، وصار طيف واسع من المتظاهرين يهتفون باسمها مطالبين بالعدالة لها، وباتت صورها تظهر مرفوعة بشكل ملحوظ بين صور ضحايا العنف الشرطي من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية.
تبع ذلك، تمرير مجلس مترو لويس فيل، مجلس مدينة لويس فيل في ولاية كنتاكي، لقانون أطلق عليه اسم «قانون بريونا» تكريمًا لها، يحظر على شرطة المدينة اقتحام المنازل بالقوة من أجل تفتيشها من دون إشعار مسبق لسكانها، مع إلزام الضباط المنفذين لقرارات التفتيش بتصوير وقائعه بالكاميرات لضمان التزامهم بما ينص عليه القانون الجديد.
ربما لولا هذا الغضب الذي يعم أرجاء الولايات المتحدة، لكان مصير قصة بريونا مثل كثير من قصص النساء اللاتي قتلهن العنف الشرطي العنصري، مرت ولم يتبعها سوى صمت مخزٍ.
لن ينقشع ظلام من دون اعتراف بالتقاطع بين العرق والنوع
التعاطي الفاتر والمُحبِط مع الانتهاكات التي تطال النساء الأمريكيات من أصول أفريقية، سواء على أيدي الشرطة أو المواطنين ذوي البشرة البيضاء، يحيلنا إلى ما يتحملنه من مكابدة التمييز القائم على اللون والعرق، الملتصق بالتمييز على أساس النوع الاجتماعي، مما يجعل العنف الذي يتعرضن له متعدد الطبقات والأوجه.
وقد كانت الباحثة النسوية والأكاديمية كيمبرلي كرينشو قد حاولت قبل أكثر من ثلاثين عامًا أن تضع إطارًا لفهم واستيعاب التجارب المركبّة للنساء الملوّنات لا سيما صاحبات البشرة السوداء مع الاضطهاد والقهر، في ضوء إهمال متعمد لهذه الحقيقة عن طريق توجيه الدراسة والتحليل في قضية التمييز العنصري إلى الرجال الملوّنين، وتوجيههما إلى النساء ذوات البشرة البيضاء عند النظر في قضية التمييز الجنسي.
تناولت كيمبرلي التشابك بين النوع والعرق وما ينتجه من مضاعفات على النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال ورقة بحثية متبّصرة نشرتها في العام 1989، تحت عنوان «إلغاء تهميش التقاطع بين العرق والجنس: نقد نسوي أسود للعقيدة المناهضة للتمييز والنظرية النسوية والسياسات المناهضة للعنصرية»، وقد ناقشت من خلالها قضية التمييز ضد النساء ذوات البشرة السوداء في عالم العمل، مستشهدةً بثلاثة أحكام قضائية رفضت أن تعترف بوجود امتزاج بين التمييز على أساس الجنس والتمييز على أساس العرق ضد النساء في التوظيف والتعيين في مواقع بعينها والترقية وحتى التسريح، وقد صدرت هذه الأحكام في قضايا: ديغرافنريد ضد شركة السيارات جينرال موتورز في العام 1976، وباين ضد شركة الرعاية الصحية ترافينول في العام ذاته، ومور ضد شركة هيوز للمروحيات في العام 1982.
رفضت المحكمة في القضايا الثلاث قبول الأطروحة المُقدّمة من صاحبات الدعاوى، التي ترمي إلى إثبات وجود اختلاف بين تجارب النساء ذوات البشرة السوداء في العمل وتجارب صاحبات البشرة البيضاء في المجال نفسه. وقد جاءت هذه القرارات استنادًا إلى العقيدة القانونية التي تعتبر أن مكافحة التمييز لا بد أن تتم على كل أساس بشكل منفصل عن الآخر، إما العرق وإما الجنس، وليس مناهضة التمييز الذي يتداخل فيه الأساسان.
في هذه الورقة أيضًا، عقدت كيمبرلي موازنة بين التمييز المتداخل والمتشابك الذي تعاني منه النساء الملوّنات والتقاطع المروري الذي قد يتعرض من يريد عبوره للاصطدام بسيارات قادمة من اتجاه واحد أو اتجاهين أو أكثر، لتتمثل بشكل مُبسّط صورة المرأة الملوّنة التي تريد أن تحقق هدفًا ما، وتواجه التمييز الجنسي من جهة، والتمييز العرقي من جهة ثانية، والتمييز الطبقي من جهة ثالثة، والتمييز بسبب الهوية الجنسية من جهة رابعة، وقد يضاف إليها جهات أخرى يرتكز فيها التمييز على ظروف الإعاقة أو السن أو الاعتقاد الديني.
عمّقت كيمبرلي كرينشو دراستها لـ «التقاطعية» في ورقة بحثية ثانية نشرتها في العام 1991 تحت عنوان «استكشاف الهامش: التقاطعية، سياسات الهوية والعنف ضد النساء الملوّنات»، لتؤسس بذلك نظريةً نسويةً ترتكز عليها عملية تحليل الاضطهادات المتشابكة بناءً على تقاطعات الجنس، والعرق، والهوية الجنسية، والطبقة والبيئة الجغرافية، والعمر، وغيرها من مسببات القمع.
ولكن رغم الصدى الذي أحدثته هذه النظرية النقدية عالميًا، فإن المعايير والسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الولايات المتحدة لا تأخذها بعين الاعتبار، وهذا ما يشكل أساسًا لقاعدة صلبة تدعم استمرار غض الطرف عن معاناة وخسائر النساء الملوّنات وبالأخص ذوات البشرة السوداء، الذي يمكننا أن نراه جليًا حتى في خضم الانتفاضة التي ترفع شعار «حيوات ذوي البشرة السوداء تستحق – Black Lives Matter».

الاستدلال على إزدواجية المعاناة بالأرقام
تبرز بوضوح عواقب إهمال «التقاطعية» وتنحيتها عن مساعي تحقيق المساواة الجندرية والمساواة العرقية، عند النظر إلى البيانات والأرقام التي تكشف اختبار النساء الملوّنات لا سيما ذوات البشرة السوداء لظواهر العنف والتمييز على اختلافها بشكل مركّب وأكثر إنهاكًا.
تعاني الأمريكيات من أصول أفريقية من ظروف الفقر بمعدلات أعلى من الرجال الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، وأعلى من نساء المجموعات العرقية المختلفة باستثناء الأمريكيات المنتميات إلى الشعوب الأصلية، وفق ما جاء في تقرير «وضع النساء ذوات البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية» الصادر عن معهد بحوث سياسات المرأة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في شهر يونيو من العام 2017، إذ تعيش ربع النساء ذوات البشرة السوداء تحت ظروف الفقر بنسبة تقدر بـ24.6 في المئة، بينما تبلغ النسبة بين النساء ذوات البشرة البيضاء 10.8 في المئة، وبين الرجال ذوي البشرة السوداء 18.9 في المئة.
وبحسب التقرير ذاته، تزيد احتمالية العيش في ظروف الفقر مع تراجع التعليم، إذ أن انتشار الفقر بين النساء اللواتي لم يتخرجن في المدرسة الثانوية أعلى بنحو ست مرات من انتشاره بين أولئك اللاتي حصلن على درجة البكالوريوس الجامعي أو ما يتجاوزها، وفقط 21.8 في المئة من النساء ذوات البشرة السوداء حصلن على درجة البكالوريوس أو ما يفوقها.
كما تفيد بيانات مركز التقدم الأمريكي للعام 2018، بأن 67.5 في المئة من الأمهات ذوات الأصول الأفريقية، هن المعيلات الرئيسات أو الوحيدات لعائلاتهن، بالمقارنة مع 37 في المئة من الأمهات ذوات البشرة البيضاء.
على صعيد آخر، تعيش النساء من أصول أفريقية معرّضات للسجن أكثر من بقية النساء في الولايات المتحدة، وتصل احتمالية سجن امرأة من ذوات البشرة السوداء إلى ضعف احتمالية سجن امرأة ذات بشرة بيضاء. وفي العام 2014، وصل عدد النساء ذوات البشرة السوداء اللائي تعرضن للسجن 109 لكل 100 ألف امرأة من ذوات البشرة سوداء، في مقابل 53 لكل 100 ألف امرأة من ذوات البشرة البيضاء، استنادًا إلى تقرير «وضع النساء ذوات البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية» الصادر في العام 2017.
وفيما يخص أزمة فيروس كورونا، يتبين أن الجائحة ضربت النساء الملوّنات أكثر من غيرهن، وبحسب تقرير أصدرته منظمة Lean In الأمريكية التى تهدف إلى «تمكين النساء وتحقيق المساواة» في شهر إبريل الماضي، هناك 54 في المئة من النساء ذوات البشرة السوداء تضررن من الجائحة اقتصاديًا سواء عبر تسريحن من العمل أو تخفيض رواتبهن، بالمقارنة مع 44 في المئة من الرجال ذوي البشرة السوداء، و31 في المئة من النساء ذوات البشرة البيضاء.
في الساحة السياسية، لم يظفر بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تأسس في العام 1789، سوى عشرة مواطنين من ذوي البشرة السوداء، ودخل إليه أول مواطن من أصل أفريقي في العام 1870 وهو السيناتور هيرام رودس ريفلز، بينما لم تدخل امرأة من أصل أفريقي إلى المجلس إلا بعد دخوله بـ 123 عامًا. وحتى يومنا هذا، يبلغ عدد النساء ذوات الأصول الأفريقية اللواتي دخلن إلى مجلس الشيوخ اثنتين فقط، هما السيناتورة كارول موزلي براون في العام 1993 والسيناتورة كمالا هاريس في العام 2017.
وفيما يتعلق بمجلس النواب، الغرفة الثانية للكونغرس الأمريكي، بلغ عدد أعضائه من ذوي الأصول الأفريقية 153 عضوةً وعضوًا حتى بداية العام 2020، كان أولهم جوزيف ريني الذي دخل المجلس في العام 1879. أما دخول المرأة الأمريكية صاحبة الأصل الأفريقي إلى مجلس النواب فقد تأخر حتى العام 1968، عندما فازت شيرلي تشيشولم في انتخابات الكونغرس، وذلك بعد 52 عامًا على دخول أول امرأة إلى هذا المجلس، حينما أضحت جانيت رانكن عضوةً عن ولاية مونتانا في العام 1916.
يصل العدد الكلي للنساء ذوات البشرة السوداء اللاتي أصبحن عضوات في مجلس النواب الأمريكي إلى 47 من أصل 325 امرأة فزن بعضوية المجلس على مدار تاريخه الممتد لـ231 عامًا.
تؤكد هذه الأرقام حقيقة معايشة النساء الأمريكيات من أصول أفريقية لاضطهادات متزامنة تزيد من هشاشة وضعهن، وهي المعاناة التي ستظل قائمة ما دام خطاب البحث عن العدالة يقدّم «التجربة الذكورية» على حساب تجاربهن، ويتمسك بالتصاعدية الهرمية التي تضع الرجل الملوّن قبل المرأة الملوّنة، وهو خطاب يتشدق بالمساواة، وفي حقيقته يبطن تعميقًا لأزمة النساء مع العنف المُركّب.


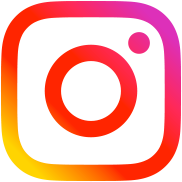





 by
by