وردي مقابل أزرق: الطفولة التعيسة.. عقوبة التعبير الجندري المُخالف للتوّقعات الاجتماعية
تتشكل تصوّرات الأطفال إناثًا وذكورًا عن الأدوار الجندرية داخل المنزل، وتؤكدها المدرسة في مرحلة تالية، ثم يرّسخها الإعلام والقيم السائدة في المجتمع. هذه الأدوار تحددها المجتمعات بأمرين رئيسين وهما المظهر والسلوك، ولذلك بمجرد أن يولد الأطفال، يعمل الوالدان في إطار التربية والتنشئة، على تعزيز الصور النمطية الجنسانية لديهم، وخلق حدود فاصلة بين عالمي الذكور والإناث، من خلال تحديد نمط سلوكي خاص للأولاد وآخر للبنات، وتدعيم شكل معين للمظهر الخارجي الأنثوي ونظيره الذكوري، فضلًا عن تقسيم ألعاب الأطفال بناءً على الجنس، بما يساعد على إكساب الطفلات صفات كالرقة والهدوء والحنان، وسمات كالقوة والنشاط والسيطرة للأطفال الذكور.
كما يطال التقسيم النمطي الألوان، إذ توجد خيارات مفضلة للإناث وأخرى للذكور، وإن كان التقسيم يضر بالذكور أكثـر، خاصة أن عددًا من الألوان المُصنّفة باعتبارها أنثوية، ما زال غير جائز للذكور ارتدائها أو اقتناء أشياء بلونها، وإلا يوصفون بـ«الأنثويين» و«المخنثين»، بينما بات من المقبول أن تحيط المرأة نفسها بجميع الألوان وتستخدمها من دون أن تتعرض للوصم، ولذلك علاقة مباشرة بتمرد الموجة النسوية الثانية في الستينيات والسبعينيات على مظاهر قمع وتقييد النساء، ومنها الأزياء التي كانت تعوق حركتهن وتخضعهن للوصاية الذكورية.
مع صعود الموجة النسوية الثانية، اضمحل الخط الفاصل بين الأزياء النسائية والأزياء الذكورية، وارتدت النساء السترات، والبدلات، وسراويل الجينز زرقاء اللون التي بدأت علاقة الذكور بها في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت حتى منتصف الستينيات من دون شراكة نسائية.
كيف أصبحت الألوان وسيلة للتنميط الجندري؟
رغم تراجع تصنيف الألوان ما بين أنثوية وذكورية، ما برحت ثنائية الوردي والأزرق رائجة، وتتجلى بوضوح في متاجر ملابس وألعاب الأطفال، حيث لا يزال شائعًا تصنيع ألعاب وإنتاج ملابس البنات بألوان خافتة، غالبًا ما تضم بينها الوردي.
يعود تحويل الألوان إلى أحد وسائل التنميط الجندري إلى بداية القرن العشرين، بعد أن كانت ألوان الباستيل جميعها تستخدم في تصنيع ملابس ومستلزمات الأطفال من دون تفرقة على أساس الجنس.
عندما صار اللونان الوردي والأزرق مؤشرين على جنس المولودين، لم يكن تصنيفهما مثلما هو الآن، فقد تم اعتبار اللون الأزرق لونًا للفتيات بوصفه رمزًا للصفاء والهدوء وهي صفات يتوقع المجتمع أن يجدها في الإناث، في المقابل تم الترويج إلى اللون الوردي بوصفه لونًا يخص الأولاد، لكونه ظلًا من ظلال اللون الأحمر (الوردي يتشكل نتيجة امتزاج الأحمر بالأبيض) الذي يعكس القوة والجرأة والقيادة، وهي سمات ينتظر المجتمع أن تتجسد في الذكور.
وقد نشرت مجلة إيرنشو (Earnshaw’s) الأمريكية، وهي أقدم مجلة متخصصة في موضة الأطفال، في عددها الصادر في شهر يونيو من العام 1918، موضوعًا يروّج إلى اعتماد اللون الوردي للأطفال الذكور والأزرق للطفلات، بدعوى أن «الوردي المشتق من الأحمر يرمز إلى القوة والطاقة، في حين يعبر اللون الأزرق عن الرقة والعذوبة.»
في الأربعينيات، بدأ السير في الاتجاه المعاكس وأضحى اللون الأحمر معبرًا بالدرجة الأولى عن الحب والرومانسية، ولأن النسـاء وفق الرؤية النمطية السائدة «عاطفيات»، صُنّف الوردي كأحد تدريجات الأحمر لونًا أنثويًا.
التعبير الجندري تحت مقصلة القبول المجتمعي
يُعرّف «التعبير الجندري» بأنه تعبير الفرد عن نفسه وهويته ظاهريًا، من خلال الضمائر التي يفضل استخدامها عند مخطابته، والملابس التي يرتديها، وغيرها من عناصر المظهر الخارجي التي يختارها، فضلًا عن السلوك الذي يتبعه. ومن المفترض أن يبدأ الأطفال في استيعاب هويتهم الجندرية والتعبير عنها في مرحلة مبكرة من العمر، إلا أن المجتمعات لا تترك حيزًا متسعًا لاستكشاف الذات والتعبير عنها بحرية، وكثيـرًا ما تتكاتف العوامل البيئية والخارجية لطمر الهوية ولحرمان الأفراد من أن يتصرفوا بطبيعتهم، من دون خوف من الإيذاء اللفظي أو الجسدي.
نتيجة لذلك، يبطن الأطفال تصوّرات نمطية عن الجنس والنوع الاجتماعي، يتماهى أكثرهم معها ويسنون لأنفسهم قوانين سلوكية تتفق والتوقعات الثقافية والاجتماعية فيما يتعلق بالأدوار الجندرية، بينما القليل منهم هو الذي يتمرد على هذه التصوّرات، فيواجه صراعات داخلية وخارجية، وفي الغالب يضطر المتمردات والمتمردون إلى التعايش مع الإقصاء المجتمعي.
الأخ عليــا
في مراهقتها، كانت عليا ترتدي الأحذية الرياضية طوال الوقت على عكس زميلاتها وصديقاتها اللاتي يملن إلى ارتداء الأحذية المفتوحة (الصنادل) في فصل الصيف، والأحذية ذات الرقبة (البوت) في فصل الشتاء، وهو ما كان محل استنكار دائم من الأسرة والأصدقاء.
وحتى تخرجها من الجامعة، لم تضم خزانة عليا أي بلوزة (قميص نسائي) أو تنورة، وإنما كانت تقتصر على السراويل المصنوعة من الجينز، والتيشرتات الرياضية، والسترات الثقيلة، وكان ذلك يُعرّضها للسخرية.
بالإضافة إلى ذلك، لم تكن عليا من الفتيات اللاتي يذهبن إلى صالونات التجميل النسائية لتصفيف شعرهن، فكانت تكتفي بلملمته إلى الخلف، قبل أن تقصه «آلا جرسون» ويصبح قصيـرًا جدًا، ليشتد مع هذه الخطوة العنف اللفظي ضدها، ويزيد وصفها بـ«المسترجلة».
تقول عليا إن المظهر الذي اختارته لنفسها في ذلك الوقت، الذي لم يكن «أنثويـًا» بالنسبة للمجتمع أو لم يكن يحقق توقعاته لـها كـ«أنثى»، عرّضها للتنمر من زملائها في المدرسة، الإناث والذكور على حد سواء، الذين كانوا ينادونها بـ«الأخ عليا» وأحيانًا بـ«علي».
زيادة المصروف نظير البقاء في المطبخ
في طفولتها، كانت إقبال تتجاوز بتلقائية الحدود الفاصلة بين عالمها وعالم شقيقها، إذ كانت تحجم عن اللعب بالدمى والألعاب التي تحاكي أغراض المنزل كالغسالة والموقد، وتميل إلى اللعب بسيارات أخيها وطائراته، وتفضل مشاركته مشاهدة أفلام الحركة والإثارة، على المكوث أمام أفلام ديزني، وتقضي ساعات أمام جهاز البلاي ستيشن (PlayStation)، تلعب كرة القدم الإلكترونية.
تقول إقبال إن أمها كانت تتصور أن بإمكانها تصحيح سلوكها الذي كانت تراه غير طبيعي بالنسبة لفتاة، فاشترت لها مريلة مطبخ صغيرة الحجم، وصارت ترغمها على الجلوس داخله للقيام ببعض المهام البسيطة، وكانت تحفزها على ذلك بزيادة المصروف اليومي، كما جعلت شراء الحلوى مرهونًا بالابتعاد عن ألعاب شقيقها «الذكورية» والاكتفاء بألعابها «الأنثوية».
في العام 2012، انطلقت حملة «دعوا الألعاب تكون ألعابًا –Let Toys Be Toys»، في بريطانيا، بهدف تحدي القوالب النمطية الجندرية في مرحلة الطفولة، التي تتمثل بوضوح في تقسيم الألعاب والكتب على أساس الجنس.
يؤمن القائمات والقائمون على الحملة المستمرة حتى الآن، بأن الغرض من الألعاب هو الإمتاع، والتعلم، وإذكاء الخيال، وتشجيع الإبداع، ولذلك يجب أن يشعر الأطفال بحرية في اختيارها، من دون تقييد أساسه التمييز الجندري (التمييز على أساس النوع الاجتماعي).
واستجابةً للحملة، أوقف نحو 15 متجرًا من أكبر متاجر ألعاب الأطفال في بريطانيا الفصل بين الألعاب، وأزالوا اللافتات التي كانت تشير إلى تقسيمها كمجموعة للبنات وأخرى للأولاد.
لتكون ذكرًا: ارفض كل ما له علاقة بالأنوثة
ياسين البالغ من العمر 26 عامًا، كان أيضـًا يتعرض في طفولته لعنف لفظي وجسدي بسبب المعايير النمطية والتوّقعات الاجتماعية، حيث كان والده يعتدي عليه بالضرب عندما يبكي، ويزجره قائلًا «العياط ده بتاع البنات، إنما أنت راجل، مفيش راجل بيعيط.»
يُعرّف الطبيب النفسي رونالد إف ليفانت والباحثة شانا بريور في كتابهما المشترك «المعيار الصارم: الحقائق القاسية حول الذكورة والعنف»، أيديولوجية الذكورة التقليدية بأنها مجموعة شاملة من المعتقدات بشأن كيف يجب أن يفكر الذكور أو لا يفكروا، وأن يشعروا أو لا يشعروا، وأن يتصرفوا أو لا يتصرفوا، تحددها سبع قواعد إلزامية وأخرى ناهية، وهي: تجنب كل ما هو أنثوي، والسلبية تجاه الأقليات الجنسية، والاعتماد على الذات من خلال المهارات الميكانيكية، والاتصاف بالصلابة، والهيمنة، والتركيز على الجنس (دون حميمية)، وكبح العاطفة.
يتفق ياسين مع ما يطرحه الكاتبان، مؤكدًا أن «الذكورة في مجتمعاتنا تعني رفض كل ما له علاقة بالأنوثة وكراهيته، لأن الغالبية ترى الأنوثة في مرتبة أدنى من الذكورة.»
في التاسعة من عمره، كان ياسين يهوى مشاهدة عروض رقص الباليه عبر الإنترنت، وبعد أن شاهد عرضًا لفتيات صغيرات، أخبر أمه برغبته في الالتحاق بمدرسة لتعليم رقص الباليه، فرفضت رفضًا قاطعًا بزعم أن الذكور لا يرقصون وأن الرقص شأن أنثوي.
رغم ذلك، لم يفقد ياسين شغفه بالباليه وظل يشاهد عروضه، ثم بدأ يقلد خطوات الرقص أثناء المشاهدة، إلى أن اقتحم والده غرفته ذات مرة ورآه يقوم بذلك، فأنهال عليه بالضرب والسباب.
بعد ذلك اليوم، بدأ حلم ياسين بتعلم وممارسة رقص الباليه يتلاشى، وأضحت مشاهدته لعروض الباليه سرية.
يتمنى ياسين أن يزيد الاهتمام والتوعية بـ«التربية المحايدة للجندر» لأن جذور العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي، تنبت في الطفولة بسبب التربية التي تُشكّل الهويات الجندرية النمطية، ويضيف «لو شجعنا الأولاد والبنات على استكشاف عوالم بعضهما البعض، والتفاعل معها بحرية من دون إرهاب، وتوقفنا عن التقسيم النمطي للألوان، والملابس، والألعاب، والصفات، سيصبح الأطفال قادرين على التعبير عن أنفسهم بصدق، وسيترسخ بداخلهم قناعة بأننا جميعًا على قدم المساواة، وليس هناك من هو أدنى من الآخر.»
*تم تغيير الأسماء نزولًا عند رغبة أصحابها


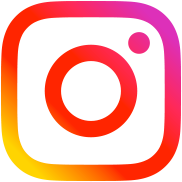





 by
by