صحيح سمرا بس دمها خفيف: العنصرية التي ننكرها.. ذاكرة ذوات البشرة الداكنة تملؤها حكايات التنمر
اتجهت الأنظار إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية شهر مايو الماضي، لتتابع بترقب الاحتجاجات المناهضة للعنف الشرطي ضد الأمريكيين من أصول أفريقية، التي أشعلها مقتل مواطن ذي بشرة سوداء يدعى جورج فلويد على يد أحد الشرطيين.
سرعان ما اتسعت أهداف الاحتجاجات التي رفعت شعار «حيوات ذوي البشرة السوداء مهمة – Black Lives Matter»، إذ صار المحتجون يطالبون بإنهاء التمييز العنصري الممنهج ضد أصحاب البشرة الملوّنة في الولايات المتحدة، ثم خرجت مظاهرات تحمل الشعارات نفسها والمطالب ذاتها في كندا وعدد من دول القارة الأوروبية بعد أن لاقت أهدافها صدى لدى المواطنات والمواطنين من أصحاب البشرة السوداء في دول مثل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وغيرها.
على الجانب الآخر، تعامل كثيرون في الدول الأفريقية الناطقة بالعربية وفي القلب منها مصر، مع هذا الغضب باعتباره أزمة تاريخية تخص المجتمعات الغربية فحسب، نتيجة ما رسخته الإمبراطوريات الاستعمارية منذ مئات السنين عن فوقية العرق الأبيض الأوروبي ودونية العرق الأفريقي الأسود، وهو حديث يستند إلى جزء من الحقيقة ويغفل الجزء الأكبر منها، لأن هذه الثقافة رسخ لها أيضًا الاستعمار الأوروبي في أفريقيا عبر وسائل عديدة، من بينها فصل القارة إلى جزأين؛ جزء شمالي (دول شمال أفريقيا) تجتمع فيه ألوان البشرة المختلفة، بيضاء وخمرية وسوداء، وجزء جنوبي يعيش فيه ذوو البشرة السوداء، وهو فصل دافعه التفريق استجاب له القسم الشمالي الذي تأثر بعمق بثقافة «التفوّق الأبيض» وتماهى معها، وصار التصوّر السائد فيه هو أن دوله وأهلها ليسوا جزءًا من أفريقيا، وتغلغلت داخله الأفكار العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء، سواء كانوا قادمين من الجنوب أو من أبناء هذه البلدان نفسها.
هذه الثقافة العنصرية تطال في ضررها النساء أكثر، لأن معايير وقوالب الجمال التي حددتها هذه المجتمعات للأنثى متأثرةً بالمجتمعات الغربية، تضع لون البشرة الأبيض على رأس ما يُعرّف ويحدد «المرأة الجميلة»، فتصبح المرأة ذات البشرة السمراء أو البشرة السوداء قبيحة في عُرف هذا المجتمع، وأكثر عرضة للسخرية من أفراده، وفي مواجهة مستمرة مع الوصم.
هدير (28 عامـًا) واحدة من هؤلاء اللاتي يلاحقهن الإيذاء النفسي بسبب لون بشرتها الداكن، وقد بدأ ذلك في طفولتها، إذ اعتاد زملاؤها في المدرسة على مناداتها باسم «شكولاتة».
«كان هذا لقبي حتى أنهيت تعليمي المدرسي، كان الجميع يناديني به، سواء رفاقي أو المعلمين وأحيانًا عاملات النظافة، وكانت صديقاتي يسجلن رقم هاتفي باسم شوكولاتة على هواتفهن.»
عادت هدير في أحد الأيام من المدرسة تبكي وتصرخ، متوسلةً إلى أمها أن تنقل أوراقها إلى مدرسة أخرى، بعد أن سخر منها أحد زملائها ولحقه اثنان آخران في فناء المدرسة، يرددان كلمات أغنية شهيرة للممثل محمد هنيدي، صدرت في العام 1998، باسم «شوكولاتة»، فذهبت الأم في اليوم التالي إلى المدرسة لتشكو إلى المديرة التي اعتبرت أن الأمر «مجرد هزار»، وبعد إصرار أمها على اتخاذ موقف واضح ضد هؤلاء الطلاب، اضطرت المديرة إلى أن تحضرهم إلى مكتبها وتأمرهم بالاعتذار إلى هدير.
تقول هدير إن تنمر زملاء الدراسة شبه اختفى في الجامعة، إلا أنه لم ينتهِ فقد صار يأتي من جهات أخرى، «عندما التحقت بالجامعة توقفت عن ربط شعري أو جمعه في كعكة، وغدوت أطلقه وهو مجعد ومتطاير لأنني أحببت شكله على هذا النحو، فباتت تلاحقني أوصاف مثل «الكرتة» و«المنكوشة» في الشارع والمواصلات العامة وفي التجمعات العائلية، وحينها أدركت أن المجتمع ما زال يرى أن الفتاة لا يحق لها أن تطلق شعرها إلا إذا كان أملسًا وانسيابيًا، حتى لو كان ذلك مصطنعًا وليس طبيعيًا.»
كانت هذه الأوصاف تزعج هدير في البداية، وكانت تضطر في أحيان كثيرة إلى ربط شعرها حتى تتجنب الإيذاء اللفظي، إلا أنها أدركت لاحقًا أن التنمر لن يتوقف، فكلما حاولت سد باب من أبوابه فُتِح آخر، فعزمت على تجاهل ما يقال وفعل ما يرضيها، ولجأت إلى سماعات هاتفها النقّال لتعرقل وصول الإساءات إلى أذنها.
ينص الدستور المصري الصادر في العام 2014، في مادته رقم (53) على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.»
كما تعتبر المادة ذاتها أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وبموجبها يتعين على الدولة تأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة جميع أشكال التمييز، إلا أن البرلمان المصري لم يناقش حتى الآن مشروع القانون الخاص بإنشاء هذه المفوضية.
أما وسام (33 عامـــًا) فقد ألِفت سماع أقاربها يواسون أمها في حظها العاثر، الذي جلب لها ابنة سمراء، إذ كانوا يرددون جملًا مثل «صحيح بنتك سمرا بس دمها خفيف» أو «هي سمرا بس مسمسة»، وكانت إحدى المعلمات في مدرستها لا تسأل عنها أو تتحدث عنها وتذكر اسمها، بل تقول «البت السمرا».
تتذكر وسام أنها عندما كانت بالصف الأول الإعدادي، وقع خلاف بينها وبين إحدى زميلاتها خلال حصة الألعاب الرياضية، وعند عودتها إلى الفصل، وجدت زميلتها قد كتبت لها على السبّورة «يا سودة يا كودة.. يا وسام يا حق الهباب وقعتي في النقرة طفشتي الكلاب»، وبينما كانت تحدق إلى هذه الكلمات بصدمة، سمعت ضحكات بعض زملائها الذين وقفوا يتابعون ردة فعلها.
صدقت وسام أنها ليست جميلة وفقدت الأمل في أن تكون كذلك، وتستدعي من بوتقة الذكريات المؤلمة، ذلك اليوم الذي جاءتها فيه إحدى صديقاتها تشكو من شعورها بالخزي والقبح لأنها ممتلئة الجسد، فردت عليها قائلة «ولكن أنت بإمكانك أن تنقصي وزنك بحمية غذائية صارمة. أما أنا لن أصبح جميلة مهما فعلت.»
في مرحلة ما أثناء طفولتها، كانت وسام تشاهد باستمرار الإعلانات التلفزيونية لأحد أشهر كريمات تفتيح البشرة، وظنت حينئذ أنه الحل السحري لما تصورته مشكلة تعاني منها، فأدخرت جزءًا من مصروفها لتشتريه.
«بعد أيام من استخدامه علمت أمي بالأمر وانزعجت بشدة، ليس بسبب دافعي وراء استعماله وإنما لقيامي بذلك مبكرًا، إذ أنني ما زلت مراهقة في المدرسة، وعندها زجرتني وقالت لي: مستعجلة ليه؟ لما تكبري فيه حاجات هتحطيها تبيضك. وكانت تقصد مستحضرات التجميل.»
في شهر يونيو الماضي ومع تعاظم احتجاجات «حيوات ذوي البشرة السوداء مهمة -Black Lives Matters»، أعلنت الذراع الهندية لشركة يونيليفير الهولندية المُنتجة لمستحضر تفتيح البشرة «فير أند لفلي» تغيير اسمه إلى «جلو أند لفلي – Glow and Lovely»، والتوقف التام عن استخدام كلمة «تبييض» في دعايتها وتسويقها لمنتجاتها، استجابة لحملة احتجاج نسوية هندية ضد العنصرية التي يرسخها هذا المنتج، كما اتخذت شركة جونسون أند جونسون قرارًا بوقف بيع منتجات تفتيح البشرة في آسيا والشرق الأوسط، بعد أن واجهت سيلًا من الانتقادات، لمساهمتها في تعزيز ثقافة أفضلية البشرة الفاتحة عن الداكنة، وأصدرت شركة لوريال بيانًا تعلن فيه توقفها عن استخدام كلمتي «تفتيح» و«تبييض» في الدعاية لمنتجاتها بعد اتهامها بـالإزدواجية، على خلفية إعلانها دعم الاحتجاجات وتضامنها مع ذوي البشرة السوداء.
على الجانب الآخر، عرفت يُمنى (25 عامــًا) التنمر بدرجة أكبر عندما انتقلت من أسوان إلى القاهرة للدراسة والعمل، وقد فوجئت بعد انتقالها بسؤالها مرارًا وتكرارًا عن ما إذا كانت مصرية أو من بلد آخر، كما لو كان جميع المصريين يجب أن يكونوا من أصحاب البشرة البيضاء أو الخمرية.
«كثيرون يتعاملون بافتراض أن أمثالي ابتلاهم الله بالبشرة السمراء، ويرون أن لون البشرة الداكن عقاب أو عيب.»
تتذكر يُمنى عندما كانت في بيت صديقة لها، وقد انضمت إليهما أمها لبعض الوقت، فجلسن يتسامرن، وبمجرد أن ابتعدت عنهما لترد على مكالمة هاتفية، سمعت الأم تقول لابنتها «ونبي طلعت دمها خفيف، سبحان الله ما بيديش كل حاجة.»
أما تقى (40 عامـــًا) وهي من صاحبات البشرة البيضاء، وعلى الرغم من أنها لم تتعرض لهذا النوع من التنمر، فقد شهدت على مواقف عديدة توثقه سواء في المجال الخاص أو العام، حتى صارت توقن أن التنمر الموّجه ضد أصحاب البشرة الداكنة ثقافة شائعة، رغم إصرار القطاع الأعرض من المجتمع على إنكار هذه الحقيقة.
في نهار يوم حار، كانت تقى تجلس في ساحة مكشوفة ملحقة بأحد مطاعم النادي الرياضي الذي تذهب إليه، ولاحظت أمًا تلاحق ابنتها الصغيرة لتعيدها إلى القاعة المكيفة، وعندما لم تفلح في إقناعها، اقتربت منها وقالت لها «لو مادخلتيش وفضلتي في الشمس هتبقي زي طنط دي»، وهي تشير إلى عاملة بالمطعم ذات بشرة داكنة.
هذه العنصرية المقيتة توجد حتى داخل بيت تقى ويمارسها أقرب الناس إليها، «عندما ذهبت بصحبة أمي لحضور خطبة ابنة عمي، وهي صاحبة بشرة داكنة، أصابت أمي الدهشة حينما رأت العريس صاحب البشرة البيضاء، والعينين العسليتين، والبنية الجسدية القوية، وهمست في أذني بتهكم: شوفتي البت السوده خدت واد عامل إزاي.. ده إيه اللي عجبه فيها؟!»
تثق تقى أن هذه المواقف تحدث في معظم البيوت، مشيرةً إلى أن كثيرين يحاولون أن ينكروا تجذر العنصرية على أساس اللون أو العرق في الثقافة الشعبية، بدعوى أن الجميع سواسية أمام القانون منذ وضعه، ولم يسبق أن شرّع البلد قوانين تحرم أحدًا من حق أساسي بسبب لون بشرته، مثلما كان الحال في دول العالم الغربي، أو استنادًا إلى أن التاريخ لم يسجل حوادث عنف دموية بين مواطنين من أصحاب البشرة البيضاء وآخرين من أصحاب البشرة السوداء، على عكس التاريخ الأمريكي الذي يكتظ بهذه الجرائم، وهي مبررات تعتقد تقى أنها لا تزيد عن كونها محاولات دفاعية لتبرير غض الطرف المستمر والتغاضي المتعمد عن جرائم العنف الجسدي واللفظي ضد أصحاب البشرة الداكنة.
انضمت مصر إلى «الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري»، في العام 1967، بموجب القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967، وتُعرّف الاتفاقية التمييز العنصري بأنه: أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها، أو ممارستها على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
وتنص الاتفاقية في مادتها رقم (7) على أن «تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام، بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية الأخرى.»


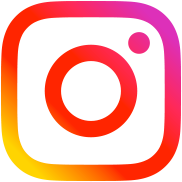





 by
by